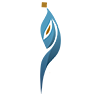المبحث الأول
آليات إصدار الفتوى المنضبطة
ويشتمل على خمسة مطالب:
المطلب الأول: مراعاة أركان مراحل الفتوى.
المطلب الثاني: مراعاة تغير الفتوى.
المطلب الثالث: مراعاة فهم النوازل فهمًا دقيقًا.
المطلب الرابع: مراعاة حال المستفتين واختيار ما يناسبهم.
المطلب الخامس: الاستفادة من وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة في الفتوى والتواصل مع المستفتين.
المطلب الأول:
مراعاة مراحل الفتوى
من المقرر لدى العلماء أن الفتوى تمر في ذهن المفتي بأربع مراحل أساسية، تخرج الفتوى بعدها في صورة جواب يتلقاه المستفتي([1])، وبيان هذه المراحل الأربع على النحو التالي:
– المرحلة الأولى: (مرحلة التصوير).
يعتبر تصوير المسألة أو الواقعة في ذهن المفتي المرحلة الأولى من مراحل الفتوى، بل إن العلماء اعتبروا هذه المرحلة الركن الأساسي في أركان الإفتاء؛ يقول إمام الحرمين الجويني: “وأول ما يجب به الافتتاح: تصوير المسألة”([2])، ويقول أيضًا: “ومن أهم ما يجب الاعتناء به: تصوير قياس الشبه، وتمييزه عن قياس المعنى”([3]).
ويقول حجَّة الإسلام الغزالي -متكلِّمًا عن علم الصحابة وعلم من بعدهم-: “فإنهم -أي الصحابة- اشتغلوا بتقعيد القواعد وضبط أركان الشريعة وتأسيس كلياتها ولم يصوِّروا المسائل تقديرًا ولم يبوِّبوا الأبواب تطويلًا وتكثيرًا، ولكنهم كانوا يجيبون عن الوقائع مكتفين بها، ثم انقلبت الأمور إذ تكررت العصور وتقاصرت الهمم وتبدلت السير والشيم، فافتقر الأئمة إلى تقدير المسائل وتصوير الوقائع قبل وقوعها ليسهل على الطالبين أخذها عن قرب من غير معاناة تعب”([4]).
فهذه المرحلة تعتبر من أهم مراحل الفتوى؛ حيث يتم فيها تصوير المسألة أو الحادثة التي أثيرت من قبل السائل، والتصوير الصحيح المطابق للواقع شرط أساسي لصدور الفتوى بشكل صحيح يتناسب مع الواقع المعيش، يقول ابن دقيق العيد -عند ذكر مسألة تعارض نصَّين كل واحد منهما بالنسبة للآخر عام من وجه خاص من وجه-: “وتحقيق ذلك أولًا يتوقف على تصوير المسألة”([5]).
لذا ينبغي على المفتي أن يتحرى بواسطة السؤال عن الجهات الأربع التي تختلف الأحكام باختلافها، وكثيرًا ما يتم الخلط والاختلاط من قبل السائل بشأنها، وهي الزمان والمكان والأشخاص والأحوال؛ يقول إمام الحرمين الجويني: “المسألة إذا حُقِّق تصويرها لم يبق فيها خلاف”([6]).
كما ينبغي على المفتي أيضًا أن يتأكد من تعلق سؤال المستفتي بالأفراد وبالأمة؛ لأن الفتوى تختلف بهذين الأمرين، كما ينبغي على المفتي أن يراعي في تصويره للواقعة هل هي نازلة حدثت بالفعل أم لا؟ فقد يكون الأمر مقدرًا لم يقع بعد، وحينئذ فلا بد من مراعاة المآلات والعلاقات البينية، وبقدر ما عند المفتي من قدرة على التصوير بقدر ما تكون الفتوى أقرب لتحقيق المقاصد الشرعية وتحقيق المصلحة ودرء المفسدة([7]). فوضع الصور للمسائل والقضايا التي تحدث ليس بأمر هين في نفسه، يقول ابن الصلاح: “… لأن تصوير المسائل على وجهها، ثم نقل أحكامها بعد استتمام تصويرها جلياتها وخفياتها، لا يقوم به إلا فقيه النفس، ذو حظ من الفقه”([8]).
فالمفتي الذكي ربما يقدر على الفتوى في كل مسألة إذا ذكرت له صورتها، ولو كُلِّف وضع الصور وتصوير كل ما يمكن من التفريعات والحوادث في كل واقعة عجز عنه، ولم يخطر بقلبه تلك الصور أصلا، وإنما ذلك شأن المجتهد.
وقد نص أهل العلم على أنه: لا يجوز للمفتي التساهل في تصور المسألة، والتسرع في الفتوى قبل استيفاء النظر والفكر في المسؤول عنه، ويلزمه التوقف عن الجواب عند عدم تصور الواقعة؛ لعدم القدرة على تحقيق المناط المناسب لها، وأن يستفسر مِن السائل عن مقصوده، ويطلب منه بيان مراده؛ ليتمكن من الجواب الصحيح له([9])؛ يقول الإمام النووي: “إذا لم يفهم المفتي السؤال أصلًا ولم يحضر الواقعة، فقال الصيمري: يكتب يزاد في الشرح ليجيب عنه، أو لم أفهم ما فيها فأجيب.. وقال الخطيب: ينبغي له إذا لم يفهم الجواب أن يرشد المستفتي إلى مفتٍ آخر إن كان، وإلا فليمسك حتى يعلم الجواب”([10]).
– المرحلة الثانية: (مرحلة التكييف).
التكييف هو إلحاق الصورة المسؤول عنها بما يناسبها من أبواب الفقه ومسائله، فنكيف المسألة مثلا على أنها من باب المعاملات لا العبادات، أو أنها من قسم مُسمَّى منها أو من العقود الجديدة غير المسماة، وهذه مرحلة تهيئ لبيان حكم المسألة الشرعي، والتكييف من عمل المفتي، ويحتاج إلى نظر دقيق.
وقد يختلف العلماء في التكييف، وهذا الاختلاف أحد أسباب اختلاف الفتوى، والترجيح بين المختلفين حينئذٍ يرجع إلى قوة دليل أي منهم، ويرجع إلى عمق فهم الواقع، ويرجع إلى تحقيق المقاصد والمصالح ورفع الحرج، وهي الأهداف العليا للشريعة([11]).
– المرحلة الثالثة: (مرحلة بيان الحكم).
الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، ويؤخذ هذا من الكتاب والسنة والإجماع، ويتم إظهاره أيضًا بواسطة القياس والاستدلال.
ويجب على المفتي أن يكون مُدركًا للكتاب والسنة ومواطن الإجماع وكيفية القياس ودلالات الألفاظ العربية وترتيب الأدلة وطرق الاستنباط وإدراك الواقع إدراكًا صحيحًا، ويتأتَّى هذا بتحصيله لعلوم الوسائل والمقاصد، كالأصول والفقه واللغة والحديث ونحوها، وبتدريبه على الإفتاء الذي ينشئ لديه ملكة راسخة في النفس يكون قادرًا بها على ذلك، وكذلك تحليه بالتقوى والورع والعمل على ما ينفع الناس([12]).
– المرحلة الرابعة: (الإفتاء).
أو مرحلة تنزيل الحكم الذي توصل إليه على الواقع الذي أدركه، وحينئذٍ فلا بد عليه من التأكد أن هذا الذي سيفتي به لا يكرُّ على المقاصد الشرعية بالبطلان، ولا يخالف نصًّا مقطوعًا به ولا إجماعًا مُتفقًا عليه ولا قاعدة فقهية مستقرة، فإذا وجد شيئًا من هذا فعليه بمراجعة فتواه حتى تتوفر فيها تلك الشروط([13]).
المطلب الثاني:
مراعاة تَغيُّر الفتوى
تتغير الفتوى بعدة عوامل، ومراعاة هذه العوامل مدخل رئيس لآلية إصدار الفتوى المنضبطة، وهذه العوامل هي:
العامل الأول: (تغير العادة والعرف).
أولًا: (تعريف العادة والعرف):
“العادة” في اللغة: اسم لتكرير الفعل والانفعال، والعادة: الديدن والدُّرْبة والتمادي في شيء حتى يصير سجية للمرء([14])، وسميت العادة بهذا الاسم لأنَّ صاحبها يعاودها، أي: يرجع إليها مرة بعد أخرى([15]) .
و”العادة” في الاصطلاح هي: “الأمر المتكرر ولو من غير علاقة عقلية”([16]).
وقيل: هي “عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة”([17]).
و”العرف” في اللغة: ضد النكر، والعرف هو المعروف، يقال: أوله عرفًا أي معروفًا، والعرف والمعروف: هو الجود، فالعرف: هو كل ما تعرفه النفس من الخير وتأنس به وتطمئن إليه ([18]).
قال تعالى: {خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ} [الأعراف: 199]، قال الزمخشري: “العرف: هو المعروف والجميل من الأفعال” ([19]).
و”العرف” في الاصطلاح له تعريفات كثيرة، منها أنه “كل ما عرفته النفوس مما لا ترده الشريعة”([20]).
ومنها أنه: “ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول”([21]).
وقال الجرجاني في تعريفه: “العرف: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول، وهو حجة أيضًا، لكنه أسرع إلى الفهم، وكذا العادة، هي ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى”([22]).
فعلى ذلك: فالعادة اصطلاحًا ترادف العرف، وهي: “الأمر الذي يتقرر بالنفوس ويكون مقبولا عند ذوي الطباع السليمة بتكراره المرة بعد المرة، على أن لفظة العادة يفهم منها تكرر الشيء ومعاودته بخلاف الأمر الجاري صدفة مرة أو مرتين، ولم يعتده الناس، فلا يعد عادة ولا يبنى عليه حكم، والعرف بمعنى العادة أيضا”([23]).
فالعرف والعادة بمعنى واحد، مع فرق يسير بينهما، فالعادة مأخوذة من المعاودة، فإذا اعتاد الناس على شيء وتكرر منهم فعله فهو عرف، إلا أن العادة هي العمل المتكرر من الأفراد والجماعات، والعرف هو الأمر الذي تتفق عليه الجماعة من الناس، فكل عرف عادة، وليس كل عادة عرفًا([24]).
فإذا قال الفقهاء في قواعدهم: “العادة محكمة” فإنهم يعنون بالعادة هنا العرف، ولا يعنون به ما اعتاده الأفراد في بعض شؤونهم([25])؛ يقول الشيخ عبد الوهاب خلاف: “العُرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه، من قول، أو فعل، أو ترك، ويسمى العادة. وفي لسان الشرعيين: لا فرق بين العرف والعادة، فالعرف العملي: مثل تعارف الناس البيع بالتعاطي من غير صيغة لفظية. والعرف القولي: مثل تعارفهم إطلاق الولد على الذكر دون الأنثى، وتعارفهم على أن لا يطلقوا لفظ اللحم على السمك. والعرف يتكون من تعارف الناس على اختلاف طبقاتهم عامتهم وخاصتهم، بخلاف الإجماع فإنه يتكون من اتفاق المجتهدين خاصة، ولا دخل للعامة في تكوينه”([26]).
(مدى أهمية مراعاة العادة والعرف في انضباط الفتوى):
يعد العرف من الأدلة الشرعية المعتبرة، بل إن شئت قلت: إنَّه أهمها؛ إذ هو الأساس في تغير الفتوى، فحياة العباد لا تبقى على وتيرة واحدة، ولا تسير على نسق واحد، بل تختلف من فترة عن الأخرى، نظرًا لاختلاف الفكر والثقافة والتقدم في شتى مجالات الحياة، الأمر الذي يجعل من الصعوبة بمكان القول بثبات الفتوى في ظل تلك التغيرات([27]).
ومن المقرر عند علماء الشريعة أن هناك أمورًا كثيرة وكَّل الشارع الحكيم تقديرها للعرف والعادة رعاية لمصالح العباد المتجددة، والتي تختلف باختلاف الزمان والمكان وتغير الأحوال، فهناك أمور يحتاج الفقهاء في بيان حكمها إلى معرفة عادات الناس وأعرافهم في الأقوال والأفعال، فإن أقوال الناس وأفعالهم تبنى على ما اعتادوه وما تعارفوا عليه، فإذا جاء الحكم الشرعي غير مصادم لما عرفوه وألفوه كان أحرى بالرضا والقبول مما لو جاء الحكم على غير ما ألفوه وما عرفوه، والأحكام الشرعية كما هو معلوم من نصوص القرآن والسنة أحكام مرنة مليئة بالحيوية لا تتناقض مع المصالح المرسلة المتجددة، بل تتواءم معها وتسير أمامها لتنير طريقها إلى الصراط السوي، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض([28]).
يقول الشيخ ولي الله الدهلوي: “واعلم أنه إنما اختلفت شرائع الأنبياء عليهم السلام لأسباب ومصالح… وأن مراد الأنبياء عليهم السلام إصلاح ما عندهم من الارتفاقات… وأن مظان المصالح تختلف باختلاف الأعصار والعادات، ولذلك صح وقوع النسخ، وإنما مثله كمثل الطبيب يعمد إلى حفظ المزاج المعتدل في جميع الأحوال، فتختلف أحكامه باختلاف الأشخاص والزمان، فيأمر الشاب بما لا يأمر به الشائب، ويأمر في الصيف بالنوم في الجو لما يرى أن الجو مظنة الاعتدال حينئذ، ويأمر في الشتاء بالنوم داخل البيت لما يرى أنه مظنة البرد حينئذ، فمن عرف أصل الدين وأسباب اختلاف المناهج لم يكن عنده تغيير ولا تبديل”([29]).
لذا جرى الفقهاء على اختلاف مذاهبهم الفقهية على اعتبار العوائد والأعراف والرجوع إليها في تطبيق الأحكام الشرعية في مسائل كثيرة، منها: سن الحيض، والبلوغ، والإنزال، وأقل الحيض، والنفاس، والطهر وغالبها وأكثرها، والأفعال المنافية للصلاة، ومقدار النجاسات المعفو عنها، ومسائل في الأيمان والوصايا والإقرارات، إلى غير ذلك من مسائل لا تعد لكثرتها([30]).
ولهذا كانت قاعدة “العادة محكمة” من القواعد الرئيسة الكبرى في الفقه، التي قعَّدها -وضعها- الفقهاء، وفرعوا منها قواعد وضوابط تدور في فلكها وتتمم عملها، ونص العلماء على أن ما لم يأت تحديده بالشرع فإنه يحدد بالعرف.
(صيغ القواعد الفقهية التي تدل على مراعاة العادة والعرف في الفتوى):
لما كانت الأحكام الشرعية المترتِّبة على العوائد والأعراف تدور معها كيفما دارت، وهي تختلف بحسب الأزمنة والأمكنة، اشْتُرِط في المفتي أن يكون عارفًا مُلِمًّا ضابطًا بعادات الناس وأحوالهم، وإلَّا كانت فتواه مخالفة لمقاصد الشريعة، وَعُدَّ جاهلًا؛ لذا قال العلماء: “من جهل بأهل زمانه فهو جاهل”([31]).
وقد وَضَع العلماء من الفقهاء والأصوليين عدة قواعد تبين مدى وجوب مراعاة المفتي للأخذ بالعرف والعادة، وقد تعددت صياغاتهم لتلك القواعد الدالة على اعتبار العادة والعرف، لكن يمكننا أن نذكر في هذا المقام أهم تلك القواعد، وهي على النحو التالي:
1- “العادة محكمة”([32]).
2- “تعتبر العادة إذا اطردت، فإن اضطربت فلا”([33]).
3- “كل ما ورد به الشرع مطلقًا، ولا ضابط له فيه، ولا في اللغة، يرجع فيه إلى العرف”([34]).
4- “المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا”([35]).
5- “ما يعاف في العادات يكره في العبادات”([36]).
والقاعدة الأولى “العادة محكمة”: تعتبر هي أم الباب، والقواعد الثلاثة مخصصة لعمومها أو مقيدة لمطلقها، أو محددة لأبعادها([37]).
(مراعاة العادة والعرف في الفتوى جزء لا يتجزأ من إدراك الواقع الذي هو أحد أركان الفتوى):
من المقرر لدى العلماء أنه ينبغي على المفتي فهم واقع المسألة وإدراك ملابساتها ومعرفة عوائد الناس وأحوالهم؛ ليتسنى له تنزيل الحكم الصحيح على الوقائع المستجدة المعروضة عليه؛ يقول ابن القيم: “ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم:
أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علمًا.
والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان قوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر”([38]).
ولا يمكن أن يدرك المفتي الواقع إلا من خلال معرفته بعادات الناس وأعرافهم، ومن المعلوم أَنَّ الأعراف والعادات قد تتغير من زمان لآخر؛ لذلك نجد أَنَّ الفقهاء قد نصوا على أنه: “لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان”([39])، بمعنى أنه لا ينكر على المفتي تغير الأحكام المنوطة بالعرف والعادة بتغير أعراف الناس وعاداتهم، “فإذا كان عرفهم وعادتهم يستدعيان حكمًا، ثم تغيرا إلى عرف وعادة أخرى، فإن الحكم يتغير إلى ما يوافق ما انتقل إليه عرفهم وعادتهم“([40]).
فأحوال الناس وعوائدهم لا تدوم على وتيرة ومنهاج واحد، بل جرت سُنَّته سبحانه وتعالى على أن عوائدهم تختلف باختلاف أزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم؛ وكل ذلك يؤدي إلى تغير الواقع الذي تتغير الفتوى بتغيره؛ يقول ابن خلدون: “إن أحوال العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر، إنما هو اختلاف على الأيام والأزمنة وانتقال من حال إلى حال، وكما يكون ذلك في الأشخاص والأوقات والأمصار، فكذلك يقع في الآفاق والأقطار والأزمنة والدول {سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدۡ خَلَتۡ فِي عِبَادِهِ} [غافر: 85]”([41]).
لذا فمراعاة العرف والعادة أصل هام من أصول الفتوى، وقد قَرَّر مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة عشرة أَنَّ من شروط الإفتاء: “المعرفة بأحوال الناس وأعرافهم وأوضاع العصر ومستجداته، ومراعاة تغيُّرها فيما بُنِيَ على العرف المعتبر الذي لا يصادم النصَّ”([42]).
(الأدلة على وجوب مراعاة العادة والعرف في الفتوى):
مراعاة المفتي للعرف في عملية الإفتاء ليس بدعًا من الأمر، بل إنَّ نصوص الشريعة من القرآن والسنة قد دلت على وجوب مراعاة العرف وعادات الناس؛ قال تعالى: {وَلِلۡمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ} [البقرة: 241]، وقال تعالى: {لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ} [البقرة: 236].
وفي الحديث: ((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف))([43]).
ومما يستدل به لحجية العرف السنَّة التقريرية كتقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم للناس على صنائعهم وتجاراتهم، وقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين([44]). وقد أقرَّ صلى الله عليه وآله وسلم القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية([45])“([46]).
ومما يجدر الإشارة إليه أن مراعاة العرف وعادات الناس في عملية الإفتاء وتبيين الأحكام الشرعية أمر قد اعتبرته جميع المذاهب الفقهية؛ يقول القرافي: “أما العرف فمشترك بين المذاهب، ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك”([47]).
فالعرف يعتبر من الأمور الأساسية لتغير الفتوى، فلا يجوز للمفتي أن يتصدر لبيان الأحكام الشرعية دون اعتباره اختلاف الأعراف والعادات؛ يقول ابن عابدين: “أن النص معلول بالعرف فيكون المعتبر هو العرف في أي زمن كان”([48]).
(عدم مراعاة العادة والعرف في الفتوى سيؤدي إلى ظهور الكثير من أوجه الفساد والفوضى):
عدم مراعاة المفتي لعادات الناس وأعرافهم سيؤدي ذلك بالضرورة إلى حدوث الفوضى في الفتاوى، وظهور الشذوذ والتطرف، ووقوع الناس في الحرج والمشقة والحيرة، وصعوبة الوصول لمعرفة وجه الصواب والحق.
يقول ابن عابدين: “ولهذا قالوا في شروط الاجتهاد: إنه لا بد فيه من معرفة عادات الناس، فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغيُّر عرف أهله أو لحدوث ضرورة أو فساد أهل الزمان بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولًا للزم منه المشقة والضرر بالناس، ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد لبقاء العالم على أتم نظام وأحسن أحكام، ولهذا ترى مشايخ المذاهب خالفوا ما نصَّ عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها على ما كان في زمنه لعلمهم بأنه لو كان في زمانهم لقال بما قالوا به أخذًا من قواعد مذهبه”([49]).
فمن يتصدر لمنصب الإفتاء دون أن يراعي عادات الناس وأعرافهم، فهو بذلك جاهل بالدين، وضال مضل؛ يقول القرافي: “أن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدين، بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة، وليس هذا تجديدًا للاجتهاد من المقلدين حتى يشترط فيه أهلية الاجتهاد، بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليها، فنحن نتبعهم فيها من غير استئناف اجتهاد”([50]).
وقد نَصَّ العلماء على أنه ينبغي على المفتي أن يراعي العرف حتى لو أدى ذلك إلى أن يفتي الناس بما يخالف ظاهر مذهبه الفقهي؛ فلا يصح أن يعتمد على ما فهمه من نصوص مذهبه دون أن يراعي عرف زمانه وأحوال الناس من حوله؛ يقول ابن عابدين: “ليس للمفتي ولا للقاضي أن يحكما على ظاهر المذهب ويتركا العرف”([51]).
(ضوابط مراعاة العادة والعرف):
وقد اشترط الفقهاء شروطًا وضوابط لكي يكون العرف معتبرًا شرعًا، ومن أهم هذه الضوابط ما يلي:
- أن يكون ذلك العرف مطردًا أو غالبًا([52]).
- أن يكون ذلك العرف المراد تحكيمه في التصرفات قائمًا عند إنشائها، فلا يعتبر العرف المتأخر في التصرفات السابقة؛ يقول ابن نجيم: “العرف الذي تحمل عليه الألفاظ، إنما هو المقارن السابق دون المتأخر؛ ولذا قالوا: لا عبرة بالعرف الطارئ”([53]).
- ألا يوجد نص صريح يُعارِض العرف([54]).
- ألا يكون ذلك العرف مُعَطِّلًا لنص أو مناقضًا لأصل شرعي قطعي الدلالة([55]).
فمراعاة المفتي للأعراف الصحيحة وتوظيفها في معادلة الترجيح الفقهي لكل واقعة تُعرض عليه تعصمه من الزلل في الفتوى؛ يقول القرافي: “الجمود على المنقولات أبدًا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين”([56]).
كما أنَّ عدم مراعاة المفتي لعوائد الناس وأعرافهم والجمود على الفتاوى القديمة وما سُطِّر في مدونات الفقه والفتاوى منذ القدم هو من الأسباب الأساسية التي قد تؤدي إلى الخطأ في الفتوى، فتُخَالَف الشريعة بذلك، وتضيع الحقوق، ويُظْلَم الكثير؛ يقول ابن عابدين: “إن جمود المفتي أو القاضي على ظاهر المنقول، مع ترك العرف والقرائن الواضحة، والجهل بأحوال الناس، يلزم منه تضييع حقوق كثيرة، وظلم خلق كثيرين”([57]).
(أنواع العرف، وحكم العمل بكل نوع):
معرفة عوائد الناس وأعرافهم ومراعاتها كأحد المكونات المعرفية لدى المفتي لها أهمية كبيرة لا يمكن الاستغناء عنها بحال في العملية الإفتائية؛ لذا ذكر العلماء أنواع العرف وحكم مراعاة تلك الأنواع في الفتوى والعمل بمقتضاها، وتفصيل ذلك على النحو التالي:
النوع الأول (العرف الصحيح): وهو ما تعارفه الناس، ولا يخالف دليلًا شرعيًّا ولا يحل محرمًا ولا يبطل واجبًا، كتعارف الناس عقد الاستصناع، وتعارفهم تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر، وتعارفهم أن الزوجة لا تزف إلى زوجها إلا إذا قبضت جزءًا من مهرها، وتعارفهم أن ما يقدمه الخاطب إلى خطيبته من حلي وثياب هو هدية لا من المهر([58]).
وحكمه: فيجب مراعاته في التشريع وفي القضاء وفي الفتوى، وعلى المجتهد مراعاته في تشريعه؛ وعلى القاضي مراعاته في قضائه؛ وعلى المفتي مراعاته في فتواه؛ لأن ما تعارفه الناس وما ساروا عليه صار من حاجاتهم ويتفق مع مصالحهم، فما دام لا يخالف الشرع وجبت مراعاته، والشارع راعى الصحيح من عرف العرب في التشريع، ففرض الدية على العاقلة، وشرط الكفاءة في الزواج واعتبر العصبية في الولاية والإرث.
ولهذا قال العلماء: العادة شريعة محكمة، والعرف في الشرع له اعتبار، والإمام مالك بنى كثيرًا من أحكامه على عمل أهل المدينة، وأبو حنيفة وأصحابه اختلفوا في أحكامٍ بناءً على اختلاف أعرافهم، والشافعي لما هبط إلى مصر غيَّر بعض الأحكام التي كان قد ذهب إليها وهو في بغداد، لتغير العرف، ولهذا له مذهبان: قديم وجديد.
وفي فقه الحنفية أحكام كثيرة مبنية على العرف، منها إذا اختلف المتداعيان ولا بينة لأحدهما، فالقول لمن يشهد له العرف، وإذا لم يتفق الزوجان على المقدم والمؤخر من المهر فالحكم هو العرف، كمن حلف لا يأكل لحمًا فأكل سمكًا لا يحنث بناء على العرف، والمنقول يصح وقفه إذا جرى به العرف، والشرط في العقد يكون صحيحًا إذا ورد به الشرع أو اقتضاه العقد أو جرى به العرف.
وقد ألَّف المرحوم ابن عابدين رسالة سماها: “نشر العرف فيما بني من الأحكام على العرف”، ومن العبارات المشهورة: “المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، والثابت بالعرف كالثابت بالنص”([59]).
النوع الثاني (العرف الفاسد): وهو ما تعارفه الناس، ولكنه يخالف الشرع أو يحل المحرم أو يبطل الواجب، مثل تعارف الناس كثيرًا من المنكرات في الموالد والمآتم، وتعارفهم أكل الربا وعقود المقامرة([60]).
وحكمه: فلا تجب مراعاته؛ لأن في مراعاته معارضةَ دليل شرعي أو إبطالَ حكم شرعي، فإذا تعارف الناس عقدًا من العقود الفاسدة كعقد ربوي، أو عقد فيه غرر وخطر، فلا يكون لهذا العرف أثر في إباحة هذا العقد، ولهذا لا يعتبر في القوانين الوضعية عرف يخالف الدستور أو النظام العام، وإنما ينظر في مثل هذا العقد من جهة أخرى، وهي أن هذا العقد هل يعد من ضرورات الناس أو حاجياتهم، بحيث إذا أبطل يختل نظام حياتهم أو ينالهم حرج أو ضيق أو لا؟ فإن كان من ضرورياتهم أو حاجياتهم يباح؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات، والحاجات تنزل منزلتها في هذا، وإن لم يكن من ضرورياتهم ولا من حاجياتهم يحكم ببطلانه ولا عبرة لجريان العرف به([61]).
العامل الثاني: (الاستحسان):
أولًا: (تعريف الاستحسان):
“الاستحسان” في اللغة: مصدر استحسن أي عدَّ الشيء حسنًا، فهو مأخوذ من حسن الشيء يحسن حسنًا، فالحُسن ضد القبح، والحَسن ضد القبيح([62]). والجمع: محاسن، ضد مساوئ([63]).
“الاستحسان” في الاصطلاح: وقد عرفه أهل العلم من الفقهاء والأصوليين بعدة تعريفات، وأشهرها ما يلي:
1- عرفه الشيخ أبو الحسن الكرخي بأنه: “الاستحسان هو أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه، لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول”([64]).
2- وعرفه الطوفي بقوله: “وأجود ما قيل فيه -أي: في الاستحسان- أنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص”([65]).
3- وعرفه ابن رشد بقوله: “الاستحسان الذي يكثر استعماله حتى يكون أعم من القياس، هو أن يكون طارحًا لقياس يؤدي إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه، فيعدل عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثر في الحكم يختص به ذلك الموضع”([66]).
ومن خلال هذه التعريفات وغيرها نستطيع أن نقول: إنَّ المراد بالاستحسان في اصطلاح العلماء هو: “عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلي إلى مقتضى قياس خفي، أو عن حكم كلي إلى حكم استثنائي لدليل انقدح في عقله رجَّح لديه هذا العدول”([67]).
ثانيًا: (ثمرات مراعاة الاستحسان في الفتوى):
يعد مراعاة الاستحسان في الفتوى أمرًا مهمًّا وعظيم الشأن، وله ثمرات عديدة لا يمكن إغفالها، ومن أهم ثمرات مراعاة الاستحسان في الفتوى ما يلي:
1- فيه رفع للحرج، وتحقيق للسعة واليسر على المستفتين؛ يقول السرخسي: “الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس، وقيل: الاستحسان طلب السهولة في الأحكام فيما يبتلى فيه الخاص والعام، وقيل: الأخذ بالسعة وابتغاء الدعة، وقيل: الأخذ بالسماحة وابتغاء ما فيه الراحة، وحاصل هذه العبارات أنه ترك العسر لليسر وهو أصل في الدين، قال الله تعالى: {يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ} [البقرة: 185]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((خير دينكم اليسر))، وقال لعلي ومعاذ رضي الله تعالى عنهما حين وجههما إلى اليمن: ((يسرا ولا تعسرا، قربا ولا تنفرا))، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((ألا إن الدين متين، فأوغلوا فيه برفق، ولا تبغضوا عباد الله عبادة الله، فإن المنبت لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى))([68]).
2- يحافظ على مقاصد الشرع، ويحقق المصلحة؛ فهو يعتمد بقدر كبير على النظر في المآلات والتماس المصلحة، وتحري مقصود الشارع الحكيم، فالاستحسان هو عبارة عن تحرٍّ للمصلحة وضبط للمآل؛ لأن كون النظر في مآلات التطبيق معتبر شرعًا، يؤكده ويدعمه مبدأ الاستحسان الهادف إلى تحري المصلحة إبان تطبيق الحكم، وذلك عن طريق الاستثناء، من مقتضى القواعد والأقيسة؛ لذلك يقول الشاطبي في تعريف الاستحسان: “وَحَدَّهُ غير ابن العربي من أهل المذهب بأنه عند مالك: استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلي -قال- فهو تقديم الاستدلال المرسل على القياس”([69]).
ثالثًا: (حجية الاستحسان):
أنكر فريقٌ من المجتهدين الاستحسان واعتبروه استنباطًا للأحكام الشرعية بالهوى والتلذذ، يقول الروياني: “اعلم أنه لا يجوز الحكم بالاستحسان، والاستحسان هو القول بالشيء من غير حجة ودليل، ولكن بغالب الظن والحسن في العقل… قال الشافعي رضي الله عنه: لو جاز ذلك لجاز أن يشرع في الدين، ومعناه: أن يبعث من جهة نفسه شرعًا غير شرع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن القياس حجة شرعية فلا يجوز تركه بالاستحسان؛ لأنه يجوز تخصيص العموم به دون الاستحسان، فلا يترك به”([70]).
لكن جمهور العلماء يقولون بحجية الاستحسان، ويعتمدون في تقرير مذهبهم على أدلة كثيرة أهمها وأقواها: أن الشارع الحكيم قد عدل في بعض الوقائع عن مقتضى القياس، فمن أمثلة ذلك أن القياس يأبى جواز عقد السلم؛ لأن المعقود عليه معدوم عند العقد، ومع ذلك رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عقد السلم([71])، ومن ذلك أيضًا: جواز عقد الإجارة فإنه ثابت بخلاف القياس؛ لحاجة الناس إلى ذلك، فإن العقد على المنافع بعد وجودها لا يتحقق؛ لأنها لا تبقى زمانين، فلا بد من إقامة العين المنتفع بها مقام الإجارة في حكم جواز العقد لحاجة الناس إلى ذلك([72]).
والراجح الذي يظهر لنا بعد عرض رأي الفريقين المختلفين في الاستحسان: أن هذا الاختلاف في حجية الاستحسان راجع إلى أن كلا الفريقين لم يتفقا في تحديد معنى الاستحسان، فالمحتجون به يريدون منه معنى غير الذي يريده من لا يحتجون به، ولو اتفقوا على تحديد معناه ما اختلفوا في الاحتجاج به، لأن الاستحسان هو عند التحقيق عدول عن دليل ظاهر أو عن حكم كلي لدليل اقتضى هذا العدول، وليس مجرد تشريع بالهوى. وكل قاض أو مفت قد تنقدح في عقله في كثير من الوقائع مصلحة حقيقية، تقتضي العدول في هذه الجزئية عما يقضي به ظاهر النص، وما هذا إلا نوع من الاستحسان([73])؛ ولذلك يقول الشاطبي: “فإن من استحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه، وإنما رجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة في أمثال تلك الأشياء المفروضة، كالمسائل التي يقتضي القياس فيها أمرًا، إلا أن ذلك الأمر يؤدي إلى فوت مصلحة من جهة أخرى، أو جلب مفسدة كذلك”([74]).
وبذلك يتضح لنا أن الاستحسان أداة من أدوات تغير الفتوى وأنه من أهم الأصول التطبيقية التي تنتج أحكامًا متغيرة وفق الحاجة، فهو طريقة عملية في تطبيق أدلة الشريعة وقواعدها عندما تصادم واقع الناس في بعض جزئياتها، فهو النافذة التي يطل منها الفقيه والمفتي على واقعهم، فيرفع عنهم الحرج ويدفع الضرر، ويحقق المنافع بتطبيق أحكام الشريعة وأصولها.
العامل الثالث: (المصلحة):
أولًا: (تعريف المصلحة):
“المصلحة” في اللغة: مفرد: مصالح، من صَلَحَ، والصاد واللام والحاء أصل واحد على خلاف الفساد، يقال: أصلحه: ضد أفسده، وقد أصلح الشيء بعد فساده أي: أقامه، والإصلاح: نقيض الإفساد، والمصلحة: الصلاح، والاستصلاح: نقيض الاستفساد، ويقال: رأَى الإمامُ المصلحة في كذا، وهُم من أهل المصالح أو المفاسد، والمصلحة: المنفعة.
فالمصلحة في اللغة تستعمل بمعنيين: الأول: المنفعة وزنًا ومعنى. والثاني: الفعل الذي فيه صلاح([75]).
“المصلحة” في الاصطلاح: لا تخرج المصلحة في اصطلاح الشرع عما هي عليه في اللغة، إلا أنها في الاصطلاح أخص منها في اللغة، فيمكن أن تعرَّف في الاصطلاح بأنها: “المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده، من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم وفق ترتيب معين فيما بينها، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوِّت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعه مصلحة”([76]).
وبناء على ذلك: فكل ما كان فيه نفع، سواء كان بالجلب كما في تحصيل المنافع، أو بالدفع والاتقاء كما في استبعاد المضار، فهو جدير بأن يسمى مصلحة([77]).
ثانيًا: (تقسيم العلماء للمصلحة):
وقد قسَّم العلماء المصلحة باعتبارات عديدة إلى أنواع مختلفة، ما يهمنا منها هنا اعتباران: أولهما: تقسيمها باعتبار قوتها في ذاتها، وثانيهما: تقسيمها من حيث اعتبار الشارع لها.
وتنقسم المصلحة بالاعتبار الأول -قوتها في ذاتها- إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: مصلحة ضرورية، وهي التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الآخرة فوت النجاة والنعيم وحصول الخسران([78]).
القسم الثاني: مصلحة حاجية، وهي ما يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، كرخص السفر والمرض، وإباحة الصيد، والتمتع بالطيبات مما هو حلال في المأكل والمشرب والملبس والمسكن([79]).
القسم الثالث: مصلحة تحسينية، وهي الأخذ بما يليق من محاسن العادات والتجنب للأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق؛ كالطهارة وستر العورة وأخذ الزينة والتقرب بنوافل العبادات، وكآداب الأكل والشرب واللباس، وعدم الإسراف أو التقتير في المآكل والمشارب والملابس([80]).
وتنقسم بالاعتبار الثاني -من حيث اعتبار الشارع لها- إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: المصلحة المعتبرة شرعًا، وهي التي شهد الشرع باعتبارها، وقام الدليل على رعايتها من نصٍّ أو إجماع؛ كحفظ العقل المقصود بتحريم شرب الخمر، وكحفظ النفس المقصود من تشريع الردع بالقصاص في القتل العمد، وكذا مشروعية الضمان؛ لحفظ المال الذي هو مقصد شرعي معتبر أيضًا، فإذا نص الشرع على حكم ما، وأرشد بمسلك من المسالك إلى العلة التي ربط بها هذا الحكم -لما في هذا الربط من تحقق مصلحة مقصودة للشارع- فإن هذه المصلحة معتبرة، وكل واقعة وجدنا فيها هذه العلة متحققة صح تعدية الحكم إليها، ويكون شَرْع الحكم في مثل هذه الواقعة بالعلة لا بالمصلحة([81]).
القسم الثاني: المصلحة الملغاة شرعًا، وهي التي شهد الشرع ببطلانها وعدم اعتبارها بنصٍّ أو إجماع، وبعض الأصوليين يسميها المناسب الغريب، ومن أمثلة هذا النوع: القول بتساوي الأخ وأخته في الميراث؛ لوجود معنى الأخوة الجامعة بينهما، فهذا المعنى ملغى بقوله تعالى: {وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ أَن تَضِلُّواْۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ} [النساء: 176]. ومِن هذا القسم كل ما يظن فيه مصلحة، لكن نصَّ الشرع أو وقع الإجماع على عدم اعتبارها([82]).
القسم الثالث: المصلحة المسكوت عنها التي لم يشهد لها الشرع بالاعتبار أو الإلغاء، لكنها توافق مقاصد الشرع العامة: من جلب نفع أو دفع ضر، وهي ما تسمى بالمصلحة المرسلة أو المناسب المرسل، وهي موضع خلاف الأصوليين بين قائل بحجيته مطلقًا، وبين مانع من ذلك، ومتوسط بين هذا وذلك([83]).
والراجح أنه ينبغي على الفقيه والمفتي أن يراعي ذلك النوع من المصلحة في فتواه وتبيينه للأحكام الشرعية؛ لأن تشريع الأحكام ما قصد به إلا تحقيق مصالح الناس، أي جلب نفع لهم أو دفع ضرر أو رفع حرج عنهم، وأن مصالح الناس لا تنحصر جزئياتها، ولا تتناهى أفرادها وأنها تتجدد بتجدد أحوال الناس وتتطور باختلاف البيئات. وتشريع الحكم قد يجلب نفعًا في زمن وضررًا في آخر، وفي الزمن الواحد قد يجلب الحكم نفعًا في بيئة ويجلب ضررًا في بيئة أخرى([84]).
ثالثًا: (حجية المصلحة):
ذهب جمهور علماء المسلمين إلى أن المصلحة المرسلة حجة شرعية يبنى عليها تشريع الأحكام، وأن الواقعة التي لا حكم فيها بنص أو إجماع أو قياس أو استحسان، يشرع فيها الحكم الذي تقتضيه المصلحة المطلقة، ولا يتوقف تشريع الحكم بناء على هذه المصلحة على وجود شاهد من الشرع باعتبارها([85]).
ودليلهم على هذا عدة أمور، أهمها ما يلي:
1- أنَّ الشريعة ما وضعت إلا لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل([86])، وأنها كلها مصالح، إما درء مفاسد أو جلب مصالح([87])، وأن مبناها وأساسها على الحكمة، ومصالح العباد في المعاني والمعاد([88]).
2- أنَّ مصالح الناس تتجدد ولا تتناهى، فلو لم تشرع الأحكام لما يتجدد من مصالح الناس، ولما يقتضيه تطورهم واقتصر التشريع على المصالح التي اعتبرها الشارع فقط، لعطلت كثير من مصالح الناس في مختلف الأزمنة والأمكنة، ووقف التشريع عن مسايرة تطورات الناس ومصالحهم، وهذا لا يتفق وما قصد بالتشريع من تحقيق مصالح الناس([89]).
3- أنَّ من استقرأ تشريع الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين؛ يتبين أنهم شرعوا أحكامًا كثيرة لتحقيق مطلق المصلحة، لا لقيام شاهد باعتبارها([90]).
والأمثلة على ذلك كثيرة، منها على سبيل المثال لا الحصر:
– ما قام به سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه من جمع المصاحف المفرقة التي كان مدونًا فيها القرآن، ومحاربة مانعي الزكاة، واستخلاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعده.
– وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أمضى الطلاق ثلاثًا بكلمة واحدة، ومنع سهم المؤلفة قلوبهم من الصدقات، ووضع الخراج، ودوَّن الدواوين، واتخذ السجون، ووقف تنفيذ حد السرقة في عام المجاعة.
– وعثمان بن عفان رضي الله عنه جمع المسلمين على مصحف واحد ونشره وحرق ما عداه، وورَّث زوجة من طلق زوجته للفرار من إرثها.
– والسادة الحنفية حجروا على المفتي الماجن، والطبيب المجاهر، والمكاري المفلس.
– والسادة المالكية أباحوا حبس المتهم وتعزيره توصلًا إلى إقراره.
– والسادة الشافعية أوجبوا القصاص من الجماعة إذا قتلوا الواحد.
وجميع هذه المصالح التي قصدوها بما شرعوه من الأحكام هي مصالح مرسلة([91]).
رابعًا: (ضوابط المصلحة):
يشهد الواقع الذي نعيش فيه على ضرورة أن يراعي الفقيه والقاضي والمفتي المصلحة المرسلة في كثير من المسائل المستحدثة والمعاملات الجديدة، وإذا لم يكن للفقيه والقاضي والمفتي فهم وإدراك لمقاصد الشرع وحفظ ضرورياته؛ سيؤدي ذلك لغلق الباب بالمنع على كثير من المباحات أو فتحه على مصراعيه بتجويز كثير من المحظورات([92])، لذا فقد ذكر الأصوليون عدَّة ضوابط من أجل تحقق المصلحة المعتبرة والعمل بها عند النظر والاجتهاد، وأهم تلك الضوابط:
الأول: أن تكون مصلحة حقيقة وليست مصلحة وهمية، والمراد بها أن يتحقق من أن تشريع الحكم في الواقعة يجلب نفعًا أو يدفع ضررًا، وأما مجرد توهم أن التشريع يجلب نفعًا، من غير موازنة بين ما يجلبه من ضرر فهذا بناء على مصلحة وهمية([93]).
الثاني: اندراج المصلحة ضمن مقاصد الشريعة([94])، يقول الزنجاني: “ذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أن التمسك بالمصالح المستندة إلى كلي الشرع وإن لم تكن مستندة إلى الجزئيات الخاصة المعينة -جائز، مثال ذلك: ما ثبت وتقرر من إجماع الأمة أن العمل القليل لا يبطل الصلاة، والعمل الكثير يبطلها”([95]).
الثالث: أن تكون مصلحة عامة وليست مصلحة شخصية، والمراد بهذا أن يتحقق من أن تشريع الحكم في الواقعة يجلب نفعًا لأكبر عدد من الناس، أو يدفع ضررًا عنهم، وليس لمصلحة فرد أو أفراد قلائل منهم([96]).
الرابع: ألا تخالف نصوص الكتاب والسنة([97])، أو تعارض حكمًا أو مبدأ ثبت بالنص أو بالإجماع، فلا يصح اعتبار المصلحة التي تقتضي مساواة الابن والبنت في الإرث؛ لأن هذه مصلحة ملغاة لمعارضتها نص القرآن([98]).
الخامس: عدم معارضتها للقياس([99]).
السادس: عدم تفويت مصلحة أهم منها أو مساوية لها([100])، فلا يصح أن تعارض مصلحة أهم منها في القوة والرجحان، فإذا كان كذلك وكان ما تحافظ عليه هاتان المصلحتان في تفاوت بالنظر إلى الذات، كما إذا حافظت إحداهما على ضروري والأخرى على حاجي، فتُقدَّم ما تحافظ على الضروري، وكذا تُقدَّم ما تحافظ على الحاجي إذا كانت مقابلتها تحافظ على التحسيني، فإن كانتا غير متفاوتتين بل كلاهما في درجة واحدة فينظر إلى شيئين:
– مقدار الشمول؛ فالمصلحة العامة مقدَّمة على الخاصة.
– والتأكد من وقوع نتائجها؛ فالمصلحة اليقينية تقدم على الظنية.
السابع: أن يكون العمل بها في غير الأمور التعبدية، فالتكاليف الشرعية قسمان: عبادات وعادات، يقول الشاطبي: “الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبد دون الالتفات إلى المعاني، وأصل العادات الالتفات إلى المعاني”([101])، ومجال العمل بالمصلحة المرسلة إنما هو في العادات وما يتعلق بمعاملة الناس بعضهم بعضًا، لا في العبادات التي لا مجال فيها للرأي، ولا مدخل فيها للاجتهاد، ويلحق بالعبادات كل ما كان في معناها مما ليس للعقل سبيل إلى إدراك المصلحة منه؛ كالمقدرات: من الحدود وفروض الإرث وما شابه، لكن ربما يقع الاستصلاح في الوسائل المطلقة لبعض العبادات، لا في ذات العبادة وأصلها، ولا في وسائلها التوقيفية التي ورد بها الشارع، ومثال ذلك: استخدام بعض الأجهزة الحديثة لمعرفة استقبال القبلة ودخول وقت الصلاة.
وختامًا نقول: إن مراعاة هذه الضوابط تُجنِّب الفقيه والقاضي والمفتي الزلل في حكمه على الأفعال، فلا يزيغ إلى باطل إلا عندما يتهاون في التقيد بهذه الضوابط أو تدقيق النظر في حقيقتها؛ ولذا فإن تعيين المصلحة بهذا الوجه ليس من السهل بمكان، بل يحتاج إلى إعمال فكر ومزيد اجتهاد.
خامسًا: (أثر مراعاة المصلحة):
إذا كنا نسلم بأن المصلحة المرسلة أصل من أصول التشريع والاستدلال، وبأن الشريعة مبنية على رعاية المصالح ودفع المفاسد، ونشاهد في الواقع تغير المصالح وتبدل الأوصاف التي تكتنف فعل المكلف، فيكون في وقت وفي حال مصلحة، ويكون في وقت وفي حال مفسدة؛ فإنه لا بد من القول بتغير الفتوى بتغير المصلحة، بل إن المصلحة تعتبر أهم الأدلة الاجتهادية التي تعد سببًا لتغير الفتاوى والأحكام؛ وذلك لأنه ثبت بالاستقراء أن تغير الفتاوى والأحكام بتغير المصالح يتردد كثيرًا على ألسنة الفقهاء أكثر مما يتردد على تغير الفتاوى والأحكام بالعرف والاستحسان، ولعل ذلك يرجع إلى أن المصلحة أسرع في تغيرها من آن لآخر، فالأحكام التي تبنى على المصلحة تكون تابعة لهذه المصلحة دائمًا، وتدور معها حيث دارت كدورانها حول العلة سواء بسواء، تثبت بثبوتها وتنتفي بانتفائها، فإذا أبقيت المصلحة بقي الحكم الذي يترتب عليها، وإذا تغيرت المصلحة اقتضى هذا التغير حكمًا جديدًا مناسبًا للمصلحة الجديدة([102]).
العامل الرابع: (عموم البلوى):
أولًا: (تعريف عموم البلوى):
“عموم البلوى” في اللغة: العموم من عَمَّ، ومن معانيها: الشمول والجمع، يقال: عَمَّ الشيء يعم عمومًا: شمل الجماعة، يقال: عمَّهم بالعطية، أي خَيِّرٌ يعُمُّ القوم بخيره وعقله([103]).
والبلوى من الابتلاء والبلاء، ومن معانيها: الاختبار والمحنة والامتحان([104]).
“عموم البلوى” في الاصطلاح: وعموم البلوى كمركب اصطلاحي يقصد به في عرف الفقهاء والأصوليين: شيوع المحظور شيوعًا يعْسُر على المكلف معه تحاشيه([105])، وبتعبير آخر: هو شيوع البلاء بحيث يصعب على المرء التخلص أو الابتعاد عنه([106]).
فالمقصود بعموم البلوى: انتشار أمر يكثر وقوعه بين الناس، يصعب الاحتراز عنه، مما يقتضي التيسير والتخفيف.
قال الزركشي: “قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني في تعليقه: ومعنى قولنا: تعمُّ به البلوى أن كل أحد يحتاج إلى معرفته”([107]).
ومعنى هذا: أنَّ جميع المكلفين -خاصِّهم وعامِّهم- يحتاجون إلى معرفة حكم تلك الحادثة للعمل به، إذ إنهم مكلفون فيها بالفعل أو الترك([108]).
ثانيًا: (أدلة اعتبار عموم البلوى):
ومن الأدلة على اعتبار عموم البلوى في نظر الشارع حديث كبشة بنت كعب بن مالك -وكانت تحت ابن أبي قتادة- أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءًا، فجاءت هرة فشربت منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات))([109]). يقول العظيم آبادي في شرح الحديث: “علة الحكم بعدم نجاسة الهرة هي الضرورة الناشئة من كثرة دورانها في البيوت ودخولها فيه، بحيث يصعب صون الأواني عنها، والمعنى أنها تطوف عليكم في منازلكم ومساكنكم فتمسحونها بأبدانكم وثيابكم ولو كانت نجسة لأمرتكم بالمجانبة عنها”([110]).
فوجه الدلالة أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتبر شيوع الابتلاء بملابسة الهِرَّة -حينما وصفها بالطواف- أمرًا يُخَفَّفُ عنده، فلا يقال بنجاسة ما تلابسه([111]).
وحين سألت امرأةٌ أمَّ سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت: ((إني امرأة أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر. فقالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يطهره ما بعده))([112]).
فوجه الدلالة أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتبر تكرر ملابسة ثياب المرأة للمكان القذر أمرًا يخفف عنده؛ إذ تعتبر ملابسة الثياب للمكان الطاهر بعد ذلك مطهرًا لها، ولو قيل بعدم طهارة ثياب النساء حينئذ لأدَّى إلى إلحاق المشقَّة بعموم النساء([113]).
ثالثًا: (أسباب عموم البلوى):
هناك الكثير من الأسباب التي تدعو المفتي والفقيه أن يعتبر عموم البلوى في حكمه على المسائل التي تعرض له، ومن أهم تلك الأسباب ما يلي:
السبب الأول: تضمن الفعل الذي ارتبط به المكلف أمرًا يشق الاحتراز عنه، ومثال ذلك: إذا دخل إلى حلق الصائم ذباب أو بعوض أو غبار طريق أو غربلة دقيق، فإنه لا يفطر لمشقة الاحتراز عنه([114]).
السبب الثاني: تعدد وقوع الشيء، وتكراره بحيث يعسر الاستغناء عنه، ومثال ذلك: أن مس المصحف من الصبيان للتعلم والاستظهار، مما يتكرر وقوعه ولا يمكن الاستغناء عنه، فلو كلف الأولياء أمر الصبيان بالوضوء لشق ذلك عليهم، فأبيح لهم ترك الوضوء([115]).
السبب الثالث: شيوع الشيء وانتشاره ووقوعه عامًّا للمكلفين أو لكثير منهم في عموم أحوالهم أو في حال واحدة بحيث يلزم عسر الاستغناء عن العمل به، ومثال ذلك: أن أعمال الطاعات كتعليم القرآن والأذان والإمامة منتشرة، ومع أن الأصل فيها أن تفعل بدون أجرة إلا أن الشرع أجاز دفع الأجرة على القيام بها؛ لأنه لو كلفت الناس بها دون أجرة لشق ذلك عليهم، وربما أدى إلى ضياع الأعمال([116]).
السبب الرابع: امتداد زمن الشيء بحيث يلزم من التكليف معه عسر احتراز عنه، ومثال ذلك: أن المستحاضة ومن به سلس بول ومن لا يرقأ جرحه وأمثالهم من أهل الأعذار قد يمتد الزمان الذي يحل به العذر، ويلزم من التكليف بالوضوء لكل صلاة مشقة، فجاز الجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد، وكذلك بين المغرب والعشاء([117]).
السبب الخامس: وقوع الفعل أو الحال مشتملًا على ضرر يلزم من التكليف معه عسر احتراز منه، ومثال ذلك: أن البقاء على الزوجية عند التنافر فيه ضرر ديني ودنيوي على الزوجين عند التكليف بلزومه، فشرع الطلاق، وكذا الخلع، دفعًا للضرر عنهما([118]).
السبب السادس: وقوع الفعل أو الحال على وجه الاضطرار بحيث يعسر الاحتراز منه، ومثال ذلك: أن الناس قد يضطرون إلى استعمال بعض النجاسات كالروث والزبل لتسميد الأرض، ولو قيل بعدم جواز بيعه لشق ذلك على الناس([119]).
رابعًا: (شروط اعتبار عموم البلوى):
اختلف العلماء في الشروط التي تعدُّ سببًا في اعتبار عموم البلوى، لكن من أهم تلك الشروط التي ذكروها ما يلي:
1- أن يكون عموم البلوى متحققًا لا متوهمًا، بحيث يكون العمل في الواقعة مما يَعْسُرُ الاحتراز منه أو الاستغناء عنه، كنظر الطبيب إلى عورة المريض، يكون إلى الموضع الذي يحتاج إلى النظر إليه فقط لا يتعداه إلى غيره مما لا تدعو إليه الضرورة، وأن يكون وقوعه عامًّا للأشخاص وإن لم يكن متحققًا لجميع المكلفين ما يكفي لاعتباره عذرًا للجميع([120]).
2- أن يكون عموم البلوى من طبيعة الشيء وشأنه وحاله، لا من تساهل المكلف في التلبس بذلك الشيء، فقد ذكر النووي أنه يشترط للعفو عن النجاسة الجافة إذا دُلِّكَتْ أن تكون مُلابَسَتُهَا بالمشْي من غير تعمُّد، فلو تعمَّد يجب عليه غسل الشيء ولا يجزئه الدَّلْك والفَرْك([121]).
3- ألا يقصد التلبُّس بما تعمُّ به البلوى بقصد الترخُّص، كما إذا شربت المرأة دواء مباحًا من أجل نزول دم الحيض، لم يَجُزْ لها الفطر عند الحنابلة([122]).
4- ألا يكون عموم البلوى عبارة عن معصية؛ لأن الرُّخَصَ لا تُنَاط بالمعاصي، قال تعالى: {فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِ} [البقرة: ١٧٣]، فجعل رخصة أكل الميتة منوطة بالاضطرار حال كون المضطر غير باغٍ ولا عادٍ.
5- أن يكون الترخص في حال عموم البلوى مقيَّدًا بتلك الحال، ويزول بزواله، فما جاز لعذر بطل بزواله([123]).
خامسًا: (أثر اعتبار عموم البلوى في الفتوى):
مما لا شك فيه أن عموم البلوى لا يكون لازمًا لكل زمان، فقد يكون الأمر مما لا تعم به البلوى، ثم يصبح في زمان آخر مما تعم به البلوى؛ لذلك فإن الفتوى تتغير بسبب عموم البلوى، فينتقل المفتي من وضع الإفتاء بالحكم المناسب للحال التي لا تعم بها البلوى إلى الحكم الشرعي المناسب للحال التي عمت بها البلوى.
كما لا تخفى الحاجة الملحة للمفتي في إدراكه لمسألة عموم البلوى، والتعرُّفِ على شروطها، ومتى يتمُّ اعتبارها ومتى لا يتم، وهذا جزء أصيل من تكوين عقلية المفتي وإدراكه للواقع حتى يستطيع التمييز بين الأمور التي تُعَدُّ مما عَمَّت به البلوى، وتفيد القواعد الشرعية المرعية التخفيف بسببها، فيُفتي بما يفيد التخفيف، والأمور التي لم تتوافر فيها شروط اعتبار عموم البلوى موجبة للتخفيف، فلا يتهاون في الحكم على الواقعة بما يؤدي إلى التفريط في أحكام الشرع الشريف.
المطلب الثالث:
مراعاة فهم النوازل فهمًا دقيقًا
ينبغي على مَن يتصدَّر لأمر الفتوى أن يتأنى في فهم النازلة التي تعرض له، ولا يتسرع في الحكم عليها دون التأكد من صورتها، وقد وضع العلماء عدة أمور لا بد من التزامها ومراعاتها عند النظر في النوازل وقبل الحكم عليها، فلا يجوز بحال الإخلال بها أو بأحدها، وإلا لصار الحكم على تلك النازلة مجانبًا للصواب وبعيدًا عن الحق، ومن أهم تلك الأمور ما يلي:
أولًا: (التأكد من وقوع النازلة):
فلا يصح أن يجتهد المفتي أو الفقيه ويشغل وقته في البحث عن حكم مسألة يستحيل وقوعها أو لم تقع، ويترك ما يحتاج الناس إلى معرفته، فهذا يعد انشغالًا عن الأهم والأولى؛ وقد يفتح ذلك باب الجدال بلا فائدة تذكر، وبالإضافة إلى ذلك فإن تصور تلك النوازل التي لم تقع يكون سببًا للوقوع في الخطأ نتيجة عدم التصور الكامل للمسألة، فمما لا شك فيه أن تصور ما وقع من المسائل أفضل وأحسن وأضبط من تصور ما لم يقع، فهناك فرق بين مسائل يحتمل وقوعها ومسائل يستحيل حدوثها أو يندر وقوعها، فالأُولى لا حرج على الفقيه والمفتي والمجتهد أن ينظر فيها ويستنبط أحكامها، أما الثانية فلا يحسن بالمجتهد والفقيه والمفتي أن يضيع وقته فيها، فيشغل نفسه بما لا فائدة منه عما هو أولى وأهم.
وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من علم لا ينفع؛ فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه، قال: ((لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها))([124]).
وقد كان دأب علماء الأمة سلفًا وخلفًا عدم الانشغال بالنوازل التي لم تقع، ونهوا المستفتي أن يسأل عن تلك المسائل التي لم تقع؛ فقد أخرج الخطيب البغدادي بسنده عن نافع، عن ابن عمر قال: “لا تسألوا عما لم يكن، فإني سمعت عمر يلعن السائل عما لم يكن”([125]).
لذا ينبغي على المجتهد والفقيه والمفتي في النوازل أن يتأكد من وقوع النازلة أولًا، ولا يفترض مسائل غريبة أو نادرة الوقوع، وأما إذا كانت المسائل متوقعة الحصول أو ستحصل قطعًا؛ فإن البحث عنها جائز ومشروع، والنظر فيها مطلوب؛ وذلك لبيان أحكامها وتفصيل أحوالها؛ يقول ابن القيم: “إذا سأل المستفتي عن مسألة لم تقع، فهل تستحب إجابته أو تكره أو تخير؟ … والحق التفصيل، فإن كان في المسألة نص من كتاب الله أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أثر عن الصحابة لم يكره الكلام فيها، وإن لم يكن فيها نص ولا أثر، فإن كانت بعيدة الوقوع أو مقدرة لا تقع لم يستحب له الكلام فيها، وإن كان وقوعها غير نادر ولا مستبعد، وغرض السائل الإحاطة بعلمها ليكون منها على بصيرة إذا وقعت، استحب له الجواب بما يعلم، لا سيما إن كان السائل يتفقه بذلك ويعتبر بها نظائرها، ويقرع عليها، فحيث كانت مصلحة الجواب راجحة كان هو الأولى، والله أعلم”([126]).
ثانيًا: (أن تكون النازلة من المسائل التي يصح النظر فيها):
فلا يصح أن يضع المفتي أو الفقيه وقته في مسألة لا فائدة في البحث فيها، وأكثر ما يحدث هذا في المسائل الجدلية، فلا بد من مراعاة أن تكون النازلة مما فيه نفع الناس وما يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم.
أما تضييع الوقت للرد على تلك الأسئلة الجدلية أو التي يراد بها إعنات المسؤول أو التعالم والتفاصح أو نحو ذلك من المقاصد المذمومة فلا ينبغي للمجتهد أن يلقي لها بالًا؛ لما فيها من المفسدة الراجحة على المصلحة؛ فقد أخرج الإمام ابن عبد البر بسنده عن معاوية رضي الله عنه قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الأغلوطات))، فسره الأوزاعي قال: يعني صعاب المسائل([127]). وقد أخرج هذا الحديث أيضًا الإمام أبو داود في “سننه”([128])؛ حيث قال الإمام الخطابي في شرحه له: “ومن باب توقي الفتيا … وقد روي أنه نهى عن الأغلوطات، قال الأوزاعي: هي شرار المسائل. والأغلوطات واحدها أغلوطة، وزنها أفعولة من الغلط كالأحموقة من الحُمق، والأسطورة من السطر، فأما الغلوطات فواحدها غَلوطة اسم مبني من الغلط كالحلوبة والركوبة من الحلب والركوب.
والمعنى أنه نهى أن يعترض العلماء بصعاب المسائل التي يكثر فيها الغلط ليُستزلوا بها ويستسقط رأيهم فيها.
وفيه كراهية التعمق والتكلف كما لا حاجة للإنسان إليه من المسألة، ووجوب التوقف عما لا علم للمسؤول به. وقد روينا عَن أُبي بن كعب أن رجلًا سأله عن مسألة فيها غموض، فقال: هل كان هذا بعد؟ قال: لا. فقال: أمهلني إلى أن يكون. وسأل رجل مالك بن أنس عن رجل شرب في الصلاة ناسيًا، فقال: ولم لم يأكل ثم؟! قال: حَدَّثنا الزهري عن علي بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه))([129]).
ثالثًا: (فهم النازلة فهمًا دقيقًا):
يعد فهم النازلة بشكل دقيق من أهم الأمور التي يحتاج إليها المفتي والفقيه، بل نستطيع أن نقول: إن ذلك من أوجب الواجبات في الحكم على أي مسألة كانت؛ فقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه في كتابه إليه: “أما بعد: فإن القضاء فريضة محكمة، وسنة متبعة، افهم إذا أدلي إليك، فإنه لا ينفع كلمة حق لا نفاذ له، آس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك، حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا يخاف ضعيف من جورك”([130]).
لذلك ينبغي على المفتي أن يتفطن من مقصود السائل، ويستفصل عما يحتاج إلى استفصال، فعند التفصيل يحصل التحصيل، وإجمال الفتوى عند الحاجة إلى التفصيل يجعل الحكم واحدًا لصور مختلفة تختلف الفتوى باختلافها، فيكون المفتي مجيبًا لغير الصواب ويَهلك ويُهلك.
يقول ابن القيم في هذا الشأن: “إذا سُئِل عن رجلٍ حلف لا يفعل كذا وكذا، ففعله، لم يجز له أن يفتي بحنثه حتى يستفصله: هل كان ثابت العقل وقت فعله أم لا؟ وإذا كان ثابت العقل، فهل كان مختارًا في يمينه أم لا؟ وإذا كان مختارًا، فهل استثنى عقيب يمينه أم لا؟ وإذا لم يستثن، فهل فعل المحلوف عليه عالمًا ذاكرًا مختارًا أم كان ناسيًا أو جاهلا أو مكرهًا؟ وإذا كان عالمًا مختارًا، فهل كان المحلوف عليه داخلا في قصده ونيته أو قصد عدم دخوله فخصصه بنيته، أو لم يقصد دخوله ولا نوى تخصيصه؟ فإن الحنث يختلف باختلاف ذلك كله. ورأينا من مفتي العصر من بادر إلى التحنيث، فاستفصلناه، فوجده غير حانث في مذهب من أفتاه، وقع ذلك مرارًا؛ فخطر المفتي عظيم، فإنه موقع عن الله ورسوله، زاعم أن الله أمر بكذا وحرم كذا أو أوجب كذا”([131]).
فالمقصود من ذلك كله: أن يتنبه المفتي والفقيه إلى أهمية فهم النازلة فهمًا دقيقًا، ويحرص على الاستفصال عند قيام الاحتمال، ليفتي بعلم وحكمة، ويؤدي إلى الأمانة التي تحمَّلها كما يجب أن تؤدى.
المطلب الرابع:
مراعاة حال المستفتين واختيار ما يناسبهم
من المعلوم أن أحوال الناس تتغير من وقت إلى آخر، وتتبدل بتبدل الأماكن، وكذلك الأمر بالنسبة لحال الشخص المستفتي، فقد تنزل به الحادثة، لكن يختلف الحكم فيها تباعًا للواقع المحيط بهذا الشخص المستفتي وحاله وظروفه وملابساته([132])، كل تلك العوامل جعلت العلماء يقررون أن عملية الإفتاء لا بد وأن يراعي فيها المفتي والفقيه جهات الفتوى الأربع، وهي: (الزمان، والمكان، والأشخاص، والأحوال)، حتى تصدر الفتوى منضبطة ومناسبة لحال المستفتين، وتوضيح تلك العوامل والجهات الأربع على النحو التالي:
العامل الأول: (تغير الزمان):
المقصود بتغير الزمان تغير العادات والأحوال للناس في زمن عنه في زمن آخر، أو في مكان عنه في مكان آخر مهما اختلفت المؤثرات التي أدت إلى تغير الأعراف والعادات، وقد أُسند التغيير إلى الزمان مجازًا، فالزمن لا يتغير، وإنما الناس هم الذين يطرأ عليهم التغيير، والتغيير لا يشمل جوهر الإنسان في أصل جبلته وتكوينه، فالإنسان إنسان منذ خلق، ولكن التغيير يتناول أفكاره وصفاته وعاداته وسلوكه، مما يؤدي إلى وجود عرف عام أو خاص، يترتب عليه تبديل الأحكام المبنية على الأعراف والعادات، والأحكام الاجتهادية التي استنبطت بدليل القياس أو المصالح المرسلة أو الاستحسان أو غيرها من الأدلة الفرعية([133]).
ومن الصعوبة أن نطبق كل الأحكام الشرعية التي وجدت في زمانٍ ما على أناسٍ أُخَر يختلفون في البيئة والظروف، إذ لا بد من وجود الخلاف في بعض الأحكام([134]).
وإنما نُسب التغيير لتغير الزمان في كلام بعض أهل العلم؛ لأن الزمان هو الوعاء الذي تجري فيه الأحداث والأفعال والأحوال، وهو الذي تتغير فيه العوائد والأعراف، فنسبة تغير الفتوى لتغير الزمان من هذا الباب، ويعبر عنه أيضًا بفساد الزمان، ويُقصد بفساد الزمان فساد الناس وانحطاط أخلاقهم وفقدان الورع وضعف التقوى، مما يؤدي إلى تغيُّر الأحكام تبعًا لهذا الفساد ومنعًا له، وقد أصبح في انتشاره عرفًا يقتضي تغير الحكم لأجله، وقد حدث مثل هذا في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفي كل العصور الإسلامية([135])، والأمثلة على ذلك كثيرة، ومنها:
المثال الأول: حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، قال: جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسأله عما يلتقطه، فقال: ((عرفها سنة، ثم احفظ عفاصها ووكاءها، فإن جاء أحد يخبرك بها، وإلا فاستنفقها. قال: يا رسول الله، فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب. قال: ضالة الإبل؟ فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء، وتأكل الشجر))([136]). وكانت ضوال الإبل في زمن عمر رضي الله عنه إبلًا مرسلة تتناتج ولا يمسها أحد، حتى إذا كان زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه أمر بمعرفتها وتعريفها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها([137])، وهذا على خلاف ما بيَّنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لفساد الزمان وجرأة الناس على تناول ضوال الإبل وأخذها، ففهم عثمان رضي الله عنه الغاية من أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بترك ضوال الإبل، وهو حفظها لصاحبها، فلما فسد الزمان، حافظ على المقصود من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن خالفه ظاهرًا، ولكنه موافق لـه حقيقة([138]).
المثال الثاني: ذهب السادة الحنفية إلى أن الغاصب لا يضمن قيمة منافع المغصوب عن مدة الغصب، بل يضمن عين المغصوب إذا هلكت أو أصابها عيب؛ لأن المنافع عندهم ليست متقومة في ذاتها، وإنما تتقوم بورود العقد عليها كعقد الإجارة، ولا عقد في الغصب، ولأنها لا مماثلة بينها وبين عين الغصب لبقاء الأعيان وذهاب المنفعة([139]).
وذهب الأئمة الثلاثة إلى أن الغاصب يضمن أجرة المثل عن المال المغصوب أو منافعه، وقد أفتى المتأخرون من الحنفية بمثل ما أفتى به الأئمة الثلاثة، وانقسموا في ذلك إلى فريقين:
فريق يرى تضمين الغاصب أجرة المثل عن منافع المغصوب؛ إذا كان مال وقف، أو مال يتيم، أو مُعدًّا للاستغلال، على خلاف القياس، وذلك لفساد الناس وجرأتهم على الغصب([140]).
وفريق يرى تضمين الغاصب منافع المغصوب مطلقًا في جميع الأموال، لا في الوقف ومال اليتيم والمال المعد للاستغلال فقط، لازدياد الفساد وفقدان الوازع الديني([141]).
المثال الثالث: كان الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه، فلما فسد الزمان وأكثروا من حلف الطلاق وتتابعوا في ذلك، أوقعه عمر ثلاثًا لا واحدة([142]). فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: “كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم”([143]).
يقول ابن القيم: “والمقصود أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يخف عليه أن هذا هو السنة، وأنه توسعة من الله لعباده؛ إذ جعل الطلاق مرة بعد مرة، وما كان مرة بعد مرة لم يملك المكلف إيقاع مراته كلها جملة واحدة كاللعان، فإنه لو قال: “أشهد بالله أربع شهادات إني لمن الصادقين” كان مرة واحدة”([144]).
وقد أخذت بعض البلدان الإسلامية بالرأي الأول في قوانين الأحوال الشخصية، فلا توقع المحاكم الشرعية وبعض دور الفتوى في تلك البلاد الطلاق بلفظ الثلاث إلا واحدة([145]).
المثال الرابع: الأصل في المذهب الحنفي أن يسافر الزوج بزوجته حيث شاء إذا أقبضها معجل مهرها وتُلزم بمتابعته، ولكنَّ المتأخرين قيدوا ذلك بما إذا كان السفر مأمونًا، وأمْنُ السفر يعني الأمن على نفسها وعرضها وخلقها من الفساد والذلة، جاء في البزازية: وبعد إيفاء المهر إذا أراد أن يخرجها إلى بلاد الغربة يمنع من ذلك؛ لأن الغريب يتأذى ويتضرر لفساد الزمان ([146]).
وقد ذكر عن أبي الليث السمرقندي أنه قال: ليس لها السفر مطلقًا بلا رضاها؛ لفساد الأزمان، لأنها لا تأمن على نفسها في منزلها، فكيف إذا خرجت، وقد جعل الفقهاء ذلك راجعًا إلى اختلاف العرف، فلو خف الفساد وانصلح الناس، رجع الناس إلى الحكم الأول، جاء في الْوَلْوَالجيَّةِ أن جواب ظاهر الرواية، وهو الذي قال به أبو الليث، كان في زمانهم، أما في زماننا فلا، وقال: فجعلـه من باب اختلاف الحكم باختلاف العصر والزمان([147]).
فإذا كانت الفتوى في صدر الفقه الإسلامي على إلزام المرأة بمتابعة زوجها في السفر والغربة، ثم صارت الفتوى عند المتأخرين على عدم إلزام المرأة بذلك، فذلك يدل على أن الفتوى يمكن أن تتغير إذا تغير عرف الناس بقلة فسادهم، ومنشأ ذلك التوفيق في فهم قولـه تعالى: {أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ} [الطلاق: 6]، وقولـه تعالى: { وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ} [الطلاق: 6]، فإذا كانت متابعة الزوجة لزوجها في سفره وانتقالـه إلى بلد آخر لا يضارها، فتلتزم بالسكنى معه حيث يسكن، وإلا فلا، فإذا ثبت أن الاغتراب فيه مضارة للمرأة لم تلزم بالمتابعة، كما هو عادة زماننا لفساد الناس([148]).
وبعد هذا التفصيل وذكر تلك الأمثلة نستطيع أن نبين أنه: “لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان”([149])، أي بتغير عرف أهلها وعادتهم، فإذا كان عرفهم وعادتهم يستدعيان حكمًا ثم تغير إلى عرف وعادة أخرى، فإن الحكم يتغير إلى ما يوافق ما انتقل إليه عرفهم وعادتهم، ولذا لما كان لون السواد في زمن الإمام أبي حنيفة رحمه الله يعد عيبًا، قال بأن الغاصب إذا صبغ الثوب أسود يكون قد عيَّبه، ثم بعد ذلك لما تغير عرف الناس وصاروا يعدونه زيادة، قال صاحباه: إنه زيادة([150]).
العامل الثاني: (تغير المكان):
مما لا شك فيه أن للمكان أثرًا ملموسًا وواضحًا على تغير الفتوى، فالأماكن تختلف، والشريعة الإسلامية إنما جاءت لتنظيم حياة الناس كافة، في سائر الأزمنة والأمكنة، ومن الصعوبة بمكان أن نطبق كل الأحكام التي تناسب مكانًا أو بلدًا معينًا على أناس يعيشون في مكان أو بلد آخر يختلف في البيئة والظروف؛ إذ لا بد من وجود الخلاف في بعض الأحكام، وهو ما يترتب عليه تغير الفتوى بتغير المكان حتى تصير منضبطة تراعي حال الناس وواقعهم الذي يحيط بهم([151]).
وتغير الفتوى بتغير المكان والبيئة المحيطة بالناس له أثر مهم في تغير الأحكام الشرعية؛ لأن الناس يأخذون بعض الخصائص من البيئة والمكان الذي يعيشون فيه، وهذه الخصائص تؤثر في العادات والعرف والتعامل، لذلك تظهر عيوب القوانين بوضوح بانتقالها من أمة إلى أخرى([152]).
يروي ابن عبد البر بسنده عن مالك بن أنس يقول: “لما حج أبو جعفر المنصور دعاني، فدخلت عليه فحدثته، وسألني فأجبته، فقال: إني قد عزمت أن آمر بكتبك هذه التي وضعتها -يعني الموطأ- فينسخ نسخًا، ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها نسخة وآمرهم أن يعملوا بما فيها لا يتعدون إلى غيره، ويدعون ما سوى ذلك من هذا العلم المحدث؛ فإني رأيت أصل العلم رواية أهل المدينة وعلمهم. قال: فقلت: يا أمير المؤمنين، لا تفعل فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل، وسمعوا أحاديث، ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم، وعملوا به ودانوا به من اختلاف الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وإن ردهم عما اعتقدوه شديد، فدع الناس وما هم عليه وما اختار كل أهل بلد لأنفسهم، فقال: لعمري لو طاوعتني على ذلك لأمرت به، وهذا غاية في الإنصاف لمن فهم”([153]).
وهكذا يقرر الإمام مالك ترك الناس في الأقطار المختلفة أحرارًا في الأخذ بما سبق إليهم، أو اختيار ما يطمئنون إليه من أحكام ما دام هدف الجميع إقامة الحق والعدل في ضوء كتاب الله وسنة رسوله([154]).
العامل الثالث: (تغير الأشخاص):
من المعلوم أن المعاملات عامة والعقود بصفة خاصة لا تنشأ إلا بين أطراف يتمتع كل منهم بالأهلية اللازمة لتلقي الحقوق وتحمل الالتزامات، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال تمتع كل طرف بالشخصية القانونية([155]).
وتعرف المعاملات نوعين من الأشخاص:
النوع الأول (الشخص الطبيعي): وهو الفرد المتمثل في الإنسان، وهو يكتسب الشخصية القانونية بمولده، وهو ما تدور حوله أحكام الفقه التراثي؛ ولذا فإن تغير الشخص الطبيعي يسيرًا، والتطور الهائل جعل التغير في الشخص الاعتباري أكثر تأثيرًا على الفقه الإسلامي المعاصر.
والنوع الثاني (الشخص الاعتباري أو المعنوي): وهو مجاز قانوني يعترف بموجبه لمجموعة من الأشخاص أو الأموال بالشخصية القانونية والذمة المالية المستقلة عن أشخاص أصحابه أو مؤسسيه([156]).
وفي العصر الحديث برزت الشخصية الاعتبارية كأهم سمات ذلك العصر، وأثرت تأثيرًا بالغًا في واقع المعاملات المالية في كل مكان.
وقد أشار الفقهاء إلى شيء من تغير الأحكام على قدر ما عرفوه من صور الشخص الاعتباري، وأعطوه أحكامًا مختلفة عن الشخص الطبيعي كعدم ووجوب الزكاة فيه مثلًا، وكذلك بيت المال والمسجد والقناطر والرباطات وغيرها، وكلها أشخاص اعتبارية لها أحكام مختلفة عن الشخص الطبيعي، وفي واقعنا المعاصر تم انفصال الشخصية الاعتبارية تمامًا عن ممثليها، وكذلك تم تحديدها تحديدًا دقيقًا؛ لذلك يجب على المفتي أن يدرك هذا الواقع الجديد ولا يتعامل مع الشخصية الاعتبارية كما يتعامل مع الشخصية الطبيعية؛ ولعل أشهر مثال لهذا اللغط وهذا اللبس ما حدث في فتاوى التعامل مع البنوك المعاصرة: ما بين محرم ومبيح، وربما غاب عن كثيرين ما ذكرناه آنفًا عن الشخصية الاعتبارية. ويقاس على ذلك عالم الأحداث، وعالم الأفكار([157]).
العامل الرابع: (تغير الحال):
لقد علَّمنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن نراعي الأحوال التي تنشأ والظروف التي تستجد، مما يستدعي تغير الحكم إذا كان اجتهاديًّا، أو تأخير تنفيذه، أو إسقاط أثره عن صاحبه إذا كان الحكم قطعيًّا([158])، وخير دليل على ذلك ما ثبت من التدرج في التشريع ونزول الأحكام تبعًا للحوادث والمناسبات، وهذا إنما يدل دلالة واضحة على تغير الأحكام تبعًا لتغير المصالح وأحوال الناس([159]).
والمتأمل في سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يجد أنه كان يراعي حال من يسأله، فيجيب عن السؤال الواحد بأجوبة مختلفة، وذلك لاختلاف أحوال السائلين، فهو يجيب كل سائل بما يتناسب معه، كالطبيب يعطي كل إنسان من الدواء ما يرى أنه أشفى لمرضه وأصلح لأمره.
فمراعاة حال المستفتي في الفتوى هو دأب العلماء والفقهاء والمفتين عبر العصور والأزمان المختلفة، والدليل على ذلك اختلاف وتنوع الأحكام التي كانوا يصدرونها نظرًا لاختلاف واقع المسألة أو حال السائل متأسين في ذلك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ وقد عقد ابن القيم فصلًا كاملًا بعنوان: “تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد”، يقول ما نصه: “هذا فصل عظيم النفع جدًّا، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة، أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به؛ فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث؛ فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل”([160]). فقد بين ابن القيم في هذا الفصل ضرورة مراعاة المفتي حال السائل، وواقع السؤال ووقته، ومقاصد الشريعة.
ومن أمثلة مراعاة الحال في الفتوى ما يلي:
المثال الأول: ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى أن تقطع الأيدي في الغزو، وهو حد من حدود الله تعالى، وقد نهى عن إقامة الحد في هذه الحالة خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله تعالى من تعطيلـه أو تأخيره، وهو لحوق صاحبه بالأعداء حمية وغضبًا([161])، فعن بسر بن أرطأة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((لا تقطع الأيدي في الغزو))، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، منهم الأوزاعي: لا يرون أن يقام الحد في الغزو بحضرة العدو مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو، فإذا خرج الإمام من أرض الحرب ورجع إلى دار الإسلام أقام الحد على من أصابه([162]).
المثال الثاني: ما روي عن علقمة، قال: غزونا أرض الروم ومعنا حذيفة وعلينا رجل من قريش، فشرب الخمر، فأردنا أن نحده، فقال حذيفة: “أتحدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعون فيكم، فقال: لأشربنها وإن كانت محرمة، ولأشربن على رغم من أرغمها”([163]).
وروي أيضًا أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لم يقم الحد على أبي محجن وقد شرب الخمر يوم القادسية([164])، يقول ابن القيم تعقيبًا على هذا الأثر: “وليس في هذا ما يخالف نصًّا ولا قياسًا ولا قاعدة من قواعد الشرع ولا إجماعًا، بل لو ادُّعي أنه إجماع الصحابة كان أصوب”([165]).
ويدخل في هذا الباب ما فعلـه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أسقط الحد عمن سرق في عام المجاعة([166]).
وخلاصة ما فصلناه أنه ينبغي على الفقيه والمفتي أن يلتزم بمراعاة تغير الحال في الفتوى وتبيين الأحكام الشرعية للناس، وعليه أن ينظر في مآلات الأحكام، فحال الناس يتبدل ويتغير بتغير واقعهم، فإذا راعى ذلك خرجت الفتوى بصورة منضبطة تتناسب مع حال المستفتي، لترشده إلى الطريق المستقيم.
المطلب الخامس:
الاستفادة من وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة في الفتوى والتواصل مع المستفتين
من المقرر أن الفتوى من الأمور التي لها تعلق شديد بمعاش الناس وواقعهم؛ لأنها ترشدهم إلى الصواب والحق وما فيه النفع في أمور دينهم ودنياهم، وهذا كله مبني على مراعاة المفتي لحال الناس وظروفهم، واهتمامه بمآلات الفتوى التي تصدر عنه ومدى مناسبتها للواقع والبيئة التي تحيط بالمستفتي.
ومن هذا المنطلق نريد أن نبين في هذا المطلب أَنَّ الثروة العلمية المعاصرة والتكنولوجيا الحديثة قد أحدثت نقلة نوعية في مجال الأدوات المعرفية التي يتم بها إدراك الواقع وتقريبه في مناحيه الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، وإذا كانت حياة الناس البسيطة في القرون المتقدمة تكفي أدوات بسيطة لتحليلها، فإن حياة الناس اليوم من التعقيد بحيث غدت هذه الأدوات تشمل تخصصات بأكملها، ولما كان من الصعوبة بمكان الذي لا ينكر أن يلم الفقيه المتخصص بذلك كله؛ فإنه بحاجة إلى معرفة هذه الأدوات أولًا والاستفادة من أهل الخبرة بها ثانيًا، سواء كان ذلك في تحقيق مناط النوازل التي يراد استنباط أحكامها، أو في تحليل العناصر المعرفية التي بنيت عليها أحكام منقولة أدت إلى توجيه الفتوى فيها، من نحو تحقيق مصلحة، أو تحديد عرف، أو اكتشاف بلوى عمت في مكان أو زمان فجاء الحكم مراعيًا لها، فكل ذلك يدعونا إلى أن نقول: إنه من الضروري أن يستفيد المفتي من الوسائل والأدوات الحديثة في استنباطه للأحكام الشرعية، وكذلك الأمر في تواصله مع المستفتين في كل مكان([167]).
(كيفية استفادة المفتي من وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة في استنباط الفتوى):
قد يكون للمعلومة أثرها على الفتوى وعلى الأحكام الشرعية التي يصدرها الفقيه والمفتي بشأن مسألة ما، خاصة تلك النوازل التي لم يكن لها مثيل في الفقه الموروث، وهنا يكون المفتي والفقيه في حاجة ماسة إلى الاطلاع على تلك النازلة، وتصورها بشكل جيد، ويبحث هل تكلم فيها أحد من الفقهاء والمفتين المعاصرين له، حتى يوفر الجهد والوقت، فيبدأ في بحثه من حيث انتهوا.
ولا يخفى أن من أبرز ما طرأ على مجالات المعلومات والاتصالات في العصر الحديث استخدام الحاسب الآلي وتقنياته المختلفة، وظهور الشبكة العالمية -الإنترنت- وما ترتب على ذلك من سهولة الحصول على المعلومة وعالميتها وسرعة انتقالها([168]).
وقد أضحت وسائل الاتصال والتكنولوجيا والتقنية الحديثة جزءًا لا يتجزأ من الواقع المعاصر المعيش، وامتد تأثيرها إلى العملية الإفتائية، وأصبحت ذات تأثير كبير على كثير من الفتاوى، ولذلك أصبح لزامًا على المشتغل بالفتوى مواكبة هذا التطور، وأن يحرص على الإلمام بهذه التقنيات، والاستفادة منها في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي المناسب([169]).
ومن فوائد ذلك للمشتغل بالفتوى سهولة الوصول للنصوص الشرعية، كما تعينه على تصور المسألة، وتقلل الوقوع في الخطأ، وتسهل معرفة حقيقة الواقعة، يقول ابن القيم: “ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم، أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علمًا…”([170]).
وقد ثبت بالتجربة أن للتقنية الحديثة بقنواتها المختلفة دورًا مهمًّا في تمكين المجتهد من الاستقصاء والاستيعاب في المسألة التي يريد الاجتهاد فيها، حتى يتكون لديه تصور واضح وفهم دقيق بحقيقة المسألة([171]).
وقد باتت المصادر الإلكترونية في العصر الحاضر واسعة الانتشار بين طلبة العلم، وأصبح الكثير منهم يلجأ إليها عند بحث المسائل العلمية، نظرًا لسهولة الوصول إلى المعلومة من خلالها، بسبب وجود النظم والبرامج التي تيسر استقراء وجمع المادة المطلوبة.
فظهور التقنيات الحديثة، كأجهزة الحاسب الآلي ببرامجها المتقدمة، والأقراص الحاسوبية المدمجة التي تحوي آلاف الكتب، والموسوعات الإلكترونية، كالمكتبة الشاملة ونحوها، وشبكة الإنترنت بما تتضمنه من وسائل معينة على البحث كقواعد المعلومات ومحركات البحث التي يمكنها استقراء وجمع أغلب المعلومات المتعلقة بالمسألة المطلوبة؛ لهو مما يعين المفتي ويمهد له طريق البحث والاستنباط؛ وذلك للأسباب التالية:
- سهولة الحصول على المعلومة المراد البحث عنها.
- سرعة الوصول إليها خلال فترة وجيزة.
- إتاحة الكثير من المعلومات التي يحتاج إليها.
فهي وسائل قريبة للباحث سهلة المنال خفيفة الأحمال تغنيه عن تجشم الأسفار وقطع الأقطار، ولقاء المشايخ في شتى البلدان والأمصار([172]).
هذا، وقد نَصَّ الأصوليون الأوائل على أَنَّ للمفتي أن يعتمد على الوسائل والأدوات الموثوقة المتوفرة في زمانهم؛ كالرسائل، والكتب، وخَبَر الثقة ونحو ذلك([173])، وهذه الوسائل في عصرهم هي كالتقنيات الحديثة الموجودة في عصرنا، ولهذا يقول الغزالي: “فإن جوزنا للمفتي الاعتماد على الكتب الصحيحة التي ارتضى الأئمة رواتها قصر الطريق على المفتي، وإلا طال الأمر وعسر الخطب في هذا الزمان مع كثرة الوسائط، ولا يزال الأمر يزداد شدة بتعاقب الأعصار”([174]).
وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الاستفادة من النوازل (الفتاوى) على أنه ينبغي للمتصدرين للفتيا “مواكبة أحوال التطور الحضاري الذي يجمع بين المصلحة المعتبرة والالتزام بالأحكام الشرعية”([175]).
وبناءً على ذلك نقول: إنه من الضروري أن يتواصل الفقيه والمفتي مع أهل العلم والمفتين في عصره؛ لمناقشة ما يستجد من قضايا ونوازل حديثة عبر هذه الوسائل الحديثة، ويمكنه أن يطلع على مجهوداتهم من خلال تلك البرامج والموسوعات الحديثة، فهذه الوسائل تتيح للمجتهد أن يكون متواصلًا مع نظرائه بشكل مباشر مهما تباعدت المسافات ونأت الديار([176]).
فتَضلُّع المفتي بأساليب التقنية البحثية الحديثة، وعلى رأسها الموسوعات والبرامج ذات الصلة بالبحث الشرعي -تساعده على القيام بالبحث الشرعي، والاطلاع على ما يريده من المصادر والمراجع، مما يوفر الجهد والوقت، خاصة في عصرنا الحاضر الذي كثرت فيه المستجدات والمسائل التي تحتاج إلى إجابات شافية وبشكل سريع، فلا بد أن يستغل المفتي تطور تلك الإمكانات والتقنيات الحديثة في البحث الشرعي، ويقوم بتوظيفها بشكل جيد، يستطيع من خلالها أن يرفع من مهارته، فمثل هذه التقنيات تسهل عليه عملية البحث والتنظيم والاستقراء والتحليل، وغير ذلك مما يعود بالنفع على عملية انضباط الفتوى.
(كيفية استفادة المفتي من وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة في التواصل مع المستفتين):
هناك العديد من الوسائل الحديثة التي يستطيع المفتي أن يصل بها إلى جموع المستفتين، ومن هذه الوسائل الحديثة ما يلي:
1- التلفزيون: وهو من أكثر الوسائل انتشارًا بسبب كثرة القنوات الفضائية، والتقدم الهائل الذي تم في هذا المجال، والمتابع لبرامج هذه القنوات يلاحظ أن أغلب محطات العالم الإسلامي قد خصصت برامج للإفتاء، يقوم فيها عدد من المفتين بالإجابة عن أسئلة المشاهدين، وبيان الأحكام الشرعية لهم، وهذه البرامج تحظى بنسبة مشاهدة عالية من قبل عامة المسلمين، ويركن إليها، بل ويكتفي بها ملايين المسلمين في أصقاع المعمورة، بدليل ازدحام خطوط هواتف هذه البرامج، وتنوع الاتصالات، وتعدد مصادرها([177]).
وهذه الوسيلة من أفضل الوسائل التي يمكن للمفتي أن يستخدمها في نشر صحيح الدين، وإصدار الفتاوى المنضبطة لعموم الناس، على اعتبار أن هذه الفضائيات فتحت قنوات للتواصل بين العالم وملايين المحتاجين إليه، مما كان له الأثر الظاهر في تبصير الناس بأمور دينهم، وكشف ما قد يلتبس عليهم من الأحكام، وهو الأمر الذي لم يكن ممكنًا من دون هذه الوسيلة.
2- الإذاعة: وهو منهج شائع في هذا العصر، ولا يقل انتشارًا عن تبليغ الفتوى عبر التلفزيون، وإن كان المفتي والمستفتي هنا يعتمدان على الصوت فقط، لكن لا بأس بذلك في حالة إذا كان المفتي على قناة إذاعية رسمية موثوق بها من قبل الجهات المعنية([178]).
3- الهاتف: وهو أداة متوفرة لبعض جهات الفتوى، حيث تخصص جهة الفتوى رقمًا معينًا يتصل المستفتي من خلاله بالمفتي؛ ليجيبه على سؤاله، وقد قامت بعض جهات الفتوى بعمل إدارات مخصوصة للرد على الفتوى الهاتفية، نحو دار الإفتاء المصرية.
4- شبكة الإنترنت: وهو من أحدث ما استجد في هذا الباب، نظرًا لأن هذه التقنية أصبحت متاحة لأغلب الناس في كافة أرجاء العالم، ومما لا شك فيه أن هذه الشبكة قد يسرت على الناس سبل الحصول على المعلومات والمعارف المختلفة، ومنها الفتاوى والأحكام، خصوصًا مع توفر محركات البحث السريعة والتي يمكنها استقراء وجمع أغلب المعلومات المتوفرة على هذه الشبكة بشأن القضية المطلوبة في ثوانٍ قليلة.
وهذه الخدمة تتيح للمستفتي الذي يستخدم الإنترنت التواصل مع المفتي، أو مع ناقل الفتوى بشكل مباشر من خلال الكتابة، بحيث يكتب المستفتي السؤال ويرسله عبر الإنترنت، سواء كان هذا الإرسال عن طريق البريد الإلكتروني، أو برامج المحادثة المختلفة، أو المنصات الإلكترونية المتنوعة، أو المواقع الرسمية لجهات الإفتاء، ونحو ذلك. وبعد أن يستقبل المفتي السؤال، يجيب عنه، ثم يقوم بإرساله للمستفتي([179]).
وفي هذه الحالة نستطيع أن نقول: إنه يمكن للمستفتي أن يعتمد على جواب المفتي عبر تلك التقنيات والوسائل الحديثة بشرط أن تكون الفتوى صادرة عن جهة إفتائية رسمية، أو من يعرف بأنه أهل لهذا المنصب الخطير، وهو منصب الإفتاء والتبليغ عن رب العالمين.
فما دامت الضوابط والآداب المتعلقة بالمفتي والمستفتي حاضرة في تلك الوسيلة الحديثة، فلا حرج في استخدامها؛ وذلك لأن الشريعة حين أباحت تقليد العامي للمفتي لم تحدد لذلك وسيلة توقيفية، بل جعلت ذلك موكولًا إلى ما يتعارف عليه الناس من الوسائل الآمنة، وبما أن الوسائل الحديثة هي أدوات هذا العصر، وقد ثبت بالتجربة كونها مفيدة ونافعة فيجوز الاعتماد عليها في التقليد قياسًا على الوسائل التي تعارف عليها المتقدمون، من نقل الثقة، والخط، والكتابة، لأن حصول الظن بالوسائل الحديثة كحصوله بتلك الوسائل، ولأن القول بجواز التقليد من خلالها يؤدي إلى الرفق بالناس، والتيسير عليهم، ورفع الحرج عنهم، وهو مقصد شرعي مهم([180]).
([1]( ضوابط الفتوى، للدكتور علي جمعة محمد (ص38)، ضمن أبحاث مؤتمر الفتوى إشكاليات الواقع وآفاق المستقبل.
([2]( انظر: “البرهان في أصول الفقه”، للجويني (2/ 233).
([3]( انظر: “البرهان في أصول الفقه”، للجويني (2/ 53)
([4]( انظر: “المنخول”، للغزالي (ص608).
([5]( انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق العيد (ص289).
([6]( انظر: البرهان في أصول الفقه، للجويني (2/ 256).
([7]( ضوابط الفتوى، للدكتور علي جمعة محمد (ص38).
([8]( انظر: أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح (ص100).
([9]( انظر: أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح (ص137).
([10]( انظر: آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، للنووي (ص63).
([11]( ضوابط الفتوى، للدكتور علي جمعة محمد (ص39).
([12]( ضوابط الفتوى، للدكتور علي جمعة محمد (ص39).
([13]( ضوابط الفتوى، للدكتور علي جمعة محمد (ص40).
([14]) المخصص، لابن سِيده (3/ 326).
([15]) المصباح المنير، (2/ 436)، وتاج العروس، للزبيدي (8/ 443).
([16]) تيسير التحرير، لأمير بادشاه الحنفي (1/ 317).
([17]) الأشباه والنظائر، لابن نجيم (ص79).
([18]) لسان العرب، لابن منظور (9/ 239).
([19]) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزمخشري (2/ 190).
([20]) شرح الكوكب المنير، لابن النجار (4/ 448).
([21]) التعريفات، للجرجاني، (ص149)، ودرر الحكام في شرح مجلة الأحكام، لأمين أفندي (1/ 44)، ط. دار الجيل.
([22]) التعريفات، للجرجاني (ص149)، مرجع سابق.
([23]) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، لأمين أفندي (1/ 44)، ط. دار الجيل.
([24]) القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، للدكتور محمد بكر إسماعيل (ص151- 157).
([25]) القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، للدكتور محمد بكر إسماعيل (ص157).
([26]( علم أصول الفقه، للشيخ عبد الوهاب خلاف (ص89)، ط. مكتبة الدعوة عن الطبعة الثامنة لدار القلم.
([27]) شروط المفتي وأثرها في تغير القضايا الفقهية، للدكتور أحمد محمد لطفي (ص149).
([28]( القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، للدكتور محمد بكر إسماعيل (ص151)، ط. دار المنار.
([29]( حجة الله البالغة، للدهلوي (1/ 163)، ط. دار الجيل، بيروت- لبنان.
([30]) الأشباه والنظائر، للسيوطي (ص90)، والأشباه والنظائر، لابن نجيم (ص79)، ومجموع رسائل ابن عابدين (2/ 115).
([31]) الدر المختار وحاشية ابن عابدين، (5/ 359).
([32]( الأشباه والنظائر، للسيوطي (ص89)، ط. دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، والأشباه والنظائر، للسبكي (1/ 12)، والأشباه والنظائر، لابن نجيم (ص79).
([33]( الأشباه والنظائر، للسيوطي (ص92)، والأشباه والنظائر، لابن نجيم (1/ 81)، وشرح القواعد الفقهية، للزرقا (ص233).
([34]( الأشباه والنظائر، للسيوطي (ص98)، والمنثور في القواعد الفقهية، للزركشي (2/ 391).
([35]( غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، للحموي (4/ 206)، ط. دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، والأشباه والنظائر، لابن نجيم (1/ 84)، وشرح القواعد الفقهية، للزرقا (ص237).
([36]) مواهب الجليل، للحطاب (1/ 117)، وموسوعة القواعد الفقهية، للدكتور محمد صدقي آل بورنو (9/ 364).
([37]( القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، للدكتور محمد بكر إسماعيل (ص151).
([38]) إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم، (1/ 69).
([39]) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، لأمين أفندي (1/ 47).
([40]) شرح القواعد الفقهية، للزرقا (ص227).
([41]) مقدمة تاريخ ابن خلدون (1/ 37).
([42]) قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: (153) في دورته السابعة عشرة، عمان (المملكة الأردنية الهاشمية) من 28 جمادى الأولى إلى 2 جمادى الآخرة 1427هـ، الموافق 24- 28 حزيران (يونيو) 2006م.
([46]( صناعة الفتوى وفقه الأقليات، لابن بيه (ص350).
([47]( شرح تنقيح الفصول، للقرافي (ص448).
([48]( رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين (5/ 177).
([49]( مجموع رسائل ابن عابدين، (2/ 125)، ط. المطبعة العثمانية.
([50]( الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، للقرافي (ص218- 219).
([51]( مجموع رسائل ابن عابدين (2/ 135).
([52]( الأشباه والنظائر، لابن نجيم (ص81)، ومجلة الأحكام العدلية (ص20)، والمدخل الفقهي العام، للزرقا (ص897).
([53]( الأشباه والنظائر، لابن نجيم (ص86)، والمدخل الفقهي العام، للزرقا (ص897).
([54]( المدخل الفقهي العام، للزرقا (ص897).
([55]) المدخل الفقهي العام، لمصطفى الزرقا، (ص897)، والمدخل في الفقه الإسلامي، للدكتور محمد مصطفى شلبي (ص263).
([56]) الفروق، للقرافي (1/ 176- 177).
([57]) مجموع رسائل ابن عابدين (1/ 47).
([58]( علم أصول الفقه، للشيخ عبد الوهاب خلاف (ص89).
([59]( علم أصول الفقه، للشيخ عبد الوهاب خلاف (ص89- 90).
([60]( علم أصول الفقه، للشيخ عبد الوهاب خلاف (ص89).
([61]( علم أصول الفقه، للشيخ عبد الوهاب خلاف (ص90).
([62]( جمهرة اللغة، لابن دريد الأزدي (1/ 535)، ط. دار العلم للملايين- بيروت، ومقاييس اللغة، لابن فارس (2/ 57)، ط. دار الفكر.
([63]( مختار الصحاح، للرازي (ص73)، ط. المكتبة العصرية، بيروت- صيدا، ولسان العرب، لابن منظور (13/ 114).
([64]( كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، لعلاء الدين البخاري الحنفي (4/ 3)، ط. دار الكتاب الإسلامي.
([65]( شرح مختصر الروضة، للطوفي (3/ 197)، ط. مؤسسة الرسالة.
([66]( الاعتصام، للشاطبي (2/ 639)، ط. دار ابن عفان، السعودية.
([67]( علم أصول الفقه، للشيخ عبد الوهاب خلاف (ص79).
([68]( المبسوط، للسرخسي (10/ 145).
([69]( الاعتصام، للشاطبي (2/ 639).
([70]( بحر المذهب، للروياني (11/ 161- 162)، ط. دار الكتب العلمية.
([71]( المبسوط، للسرخسي (21/ 97).
([72]( المبسوط، للسرخسي (15/ 75).
([73]( علم أصول الفقه، للشيخ عبد الوهاب خلاف (ص83).
([74]( الموافقات، للشاطبي (5/ 194).
([75]( انظر: لسان العرب، لابن منظور (2/ 516)، ومختار الصحاح، للرازي (ص178)، والمصباح المنير، للفيومي (1/ 345)، والمعجم الوسيط (ص520).
([76]( المستصفى، للغزالي (1/ 174).
([77]( انظر: رسالة في رعاية المصلحة، للطوفي (ص25)، ط. الدار المصرية اللبنانية، وضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، للدكتور البوطي (ص23)، ط. مؤسسة الرسالة.
([78]( الموافقات، للشاطبي (2/ 17).
([79]( الموافقات، للشاطبي (2/ 21).
([80]( الموافقات، للشاطبي (2/ 22).
([81]( الموافقات، للشاطبي (2/ 24).
([82]( المصلحة الملغاة في الشرع الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة، للدكتور نور الدين مختار الخادمي (ص40)، ط. مكتبة الرشد ناشرون، المملكة العربية السعودية.
([83]( التقرير والتحبير، لابن أمير الحاج (3/ 151)، ط. دار الكتب العلمية، والموافقات، للشاطبي (3/ 41).
([84]( علم أصول الفقه، للشيخ عبد الوهاب خلاف (ص84).
([85]( علم أصول الفقه، للشيخ عبد الوهاب خلاف (ص85).
([86]( الموافقات، للشاطبي (2/ 9).
([87]( قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للعز بن عبد السلام (1/ 11)، ط. مكتبة الكليات الأزهرية – القاهرة.
([88]( إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم (3/ 11).
([89]( علم أصول الفقه، للشيخ عبد الوهاب خلاف (ص85).
([90]( علم أصول الفقه، للشيخ عبد الوهاب خلاف (ص85).
([91]( علم أصول الفقه، للشيخ عبد الوهاب خلاف (ص85- 86).
([92]( التيسير في الفتيا معالم وضوابط، للدكتور مسفر بن علي القحطاني، بحث مقدم لمؤتمر منهجية الإفتاء في عالم مفتوح، (ص24).
([93]( علم أصول الفقه، للشيخ عبد الوهاب خلاف (ص86).
([94]( ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، للبوطي (ص115– 272)، ط. مؤسسة الرسالة.
([95]( تخريج الفروع على الأصول، للزَّنْجاني (ص320)، ط. مؤسسة الرسالة- بيروت.
([96]( علم أصول الفقه، للشيخ عبد الوهاب خلاف (ص86).
([97]( ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، للبوطي (ص115– 272)، ط. مؤسسة الرسالة.
([98]( علم أصول الفقه، للشيخ عبد الوهاب خلاف (ص86).
([99]( ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، للبوطي (ص115– 272)، ط. مؤسسة الرسالة.
([100]( ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، للبوطي (ص115– 272)، ط. مؤسسة الرسالة.
([101]( الموافقات، للشاطبي (2/ 513).
([102]( تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية، للدكتور إسماعيل كوكسال، (ص189)، ط. مؤسسة الرسالة.
([103]( تاج العروس، للزبيدي (٣٣/ ١٤٩).
([104]( تاج العروس، للزبيدي (٣٧/ ٢٠٦- ٢٠٧).
([105]( معجم مصطلحات أصول الفقه، للدكتور قطب مصطفى سانو (ص٢٩٩)، ط. دار الفكر.
([106]( نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي، لوهبة الزحيلي (ص١٢٣)، ط. مؤسسة الرسالة.
([107]( البحر المحيط، الزركشي (٤/ ٣٤٧)، ط، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- الكويت.
([108]( عموم البلوى دراسة نظرية تطبيقية، للمسلم الدوسري، (ص٤٨)، ط. مكتبة الرشد- الرياض.
([109]( أخرجه أبو داود في “سننه” (1/ 19).
([110]( عون المعبود شرح سنن أبي داود، للعظيم آبادي (1/ 98- 99)، ط. دار الكتب العلمية- بيروت.
([111]( عموم البلوى دراسة نظرية تطبيقية، للمسلم الدوسري، (ص326).
([112]( أخرجه أبو داود في “سننه” (1/ 104).
([113]( عموم البلوى دراسة نظرية تطبيقية، للمسلم الدوسري، (ص330).
([114]( رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين (2/ 395).
([115]( الأشباه والنظائر، للسيوطي (ص78).
([116]( المغني، لابن قدامة (5/ 410- 411)، ط. مكتبة القاهرة.
([117]( المغني، لابن قدامة (1/ 249).
([118]( رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين (3/ 229).
([119]( بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد الحفيد (3/ 146)، ط. دار الحديث- القاهرة.
([120]( عموم البلوى دراسة نظرية تطبيقية، للمسلم الدوسري، (ص338).
([121]( المجموع، للنووي، (2/ 554).
([122]( مطالب أولي النهى، للرحيباني، (1/ 268).
([123]( عموم البلوى دراسة نظرية تطبيقية، للمسلم الدوسري، (ص351)
([125]( الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي (2/ 12).
([126]( إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم (4/ 170).
([127]( جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر (2/ 1056)، مرجع سابق.
([128]( أخرجه أبو داود في “سننه” (3/ 321).
([129]( معالم السنن، للخطابي (4/ 186)، ط. المطبعة العلمية- حلب، الطبعة الأولى، سنة ١٣٥١هـ- ١٩٣٢م.
([130]( السنن الكبرى، للبيهقي (10/ 229).
([131]( إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم (4/ 144).
([132]( شروط المفتي وأثرها في تغير الفتوى في القضايا الفقهية، للدكتور أحمد محمد لطفي (ص148).
([133]( ضوابط الفتوى، للدكتور علي جمعة محمد (ص24).
([134]( شروط المفتي وأثرها في تغير الفتوى في القضايا الفقهية، للدكتور أحمد محمد لطفي (ص163).
([135]( ضوابط الفتوى، للدكتور علي جمعة محمد (ص25).
([136]( أخرجه البخاري (3/ 124).
([137]( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 316).
([138]( ضوابط الفتوى، للدكتور علي جمعة محمد (ص25).
([139]) انظر: الاختيار لتعليل المختار، للموصلي الحنفي (3/ 64).
([140]) انظر: رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين (6/ 204).
([141]) انظر: المدخل الفقهي، للزرقا (2/ 914).
([142]( ضوابط الفتوى، للدكتور علي جمعة محمد (ص26).
([144]( إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم (3/ 32- 33).
([145]( ضوابط الفتوى، للدكتور علي جمعة محمد (ص27).
([146]) انظر: رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين (3/ 147).
([147]) انظر: رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين (3/ 146)، والمدخل الفقهي، للزرقا (2/ 914).
([148]( ضوابط الفتوى، للدكتور علي جمعة محمد (ص27).
([149]( مجلة الأحكام العدلية (ص20).
([150]( ضوابط الفتوى، للدكتور علي جمعة محمد (ص29).
([151]( شروط المفتي وأثرها في تغير الفتوى في القضايا الفقهية، للدكتور أحمد محمد لطفي (ص162- 163).
([152]( ضوابط الفتوى، للدكتور علي جمعة محمد (ص30).
([153]( جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر (1/ 532).
([154]( ضوابط الفتوى، للدكتور علي جمعة محمد (ص30).
([155]( ضوابط الفتوى، للدكتور علي جمعة محمد (ص31).
([156]( ضوابط الفتوى، للدكتور علي جمعة محمد (ص32).
([157]( الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، للدكتور سيد عبده بكر (ص115).
([158]( ضوابط الفتوى، للدكتور علي جمعة محمد (ص32).
([159]( التجديد في علوم الفتوى، للدكتورة بديعة علي أحمد الطملاوي (ص82)، ط. ضمن أبحاث مؤتمر الفتوى إشكاليات الواقع وآفاق المستقبل.
([160]( إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم (3/ 11).
([161]( ضوابط الفتوى، للدكتور علي جمعة محمد (ص32).
([162]( أخرجه الترمذي في “جامعه” (4/ 53).
([163]( أخرجه ابن أبي شيبة في “مصنفه” (5/ 549).
([164]( أخرجه عبد الرزاق في “مصنفه” (9/ 244).
([165]( إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم (3/ 14).
([166]) إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم (3/ 17).
([167]( الصياغة الفقهية في العصر الحديث، للدكتور هيثم بن فهد (ص182)، ط. دار ابن حزم.
([168]( الصياغة الفقهية في العصر الحديث، للدكتور هيثم بن فهد (ص183).
([169]( وسائل تنمية ملكة الإفتاء، للدكتور عبد العزيز النملة (ص728)، ط. ضمن أبحاث مؤتمر الفتوى واستشراف المستقبل.
([170]( إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم (1/ 69).
([171]( وسائل تنمية ملكة الإفتاء، للدكتور عبد العزيز النملة (ص730).
([172]) النوازل الأصولية، للدكتور أحمد الضويحي (ص42). ط. كلية الشريعة- السعودية، ووسائل تنمية ملكة الإفتاء، للدكتور عبد العزيز النملة (ص730).
([173]) المستصفى، للغزالي (ص344)، وفتاوى ابن الصلاح (1/ 52)، وأدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح (ص115- 116)، وآداب الفتوى والمفتي والمستفتي، للنووي (ص41)، والأشباه والنظائر، للسيوطي (ص310- 311).
([174]) المستصفى، للغزالي (ص344).
([175]) قرارات وتوصيات مجمع الفقهي الإسلامي رقم: 104 (7/ 11) بشأن سبل الاستفادة من النوازل (الفتاوى)، 1419هـ- 1998م.
([176]( النوازل الأصولية، للدكتور أحمد الضويحي (ص44).
([177]( النوازل الأصولية، للدكتور أحمد الضويحي (ص69).
([178]( النوازل الأصولية، للدكتور أحمد الضويحي (ص71).